ARTICLE AD BOX
في دارج ما عرفناه عن إسرائيل هو عزوفها عن الحروب الطويلة، وحساسيتها إزاء خسارة جنودها. فهذا ليس في صلب العقيدة العسكرية والأمنية الإسرائيلية، المجبولة على الواقعية السياسية، فحسب، بل يمكن القول إنه متجذر في مثاليات ليبرالية غربية، يغذيها منطق فوقي تطهري، وتجادل بـ"قدسية الحياة وجوهريتها". ونقرأ هذا، على سبيل المثال، في خطاب ديفيد بن غوريون، الأب المؤسّس لإسرائيل، أمام قادة جيشه عام 1950، إذ قال إنّ "حياة الإنسان مقدسة" وأنها "الغاية لا الوسيلة"، وذلك أيضاً مُضمّن، في تصريف آخر، ضمن الدستور غير المكتوب للدولة والمسمى بـ"قوانين الأساس"، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي تغيّر اليوم؟
الحديث هنا لم يعد عن القابلية العالية لدى المجتمع الإسرائيلي لتلقي أخبار النعي اليومي لجنوده ومستوطنيه في الضفة وغزة وحسب، بل أيضاً تلقي أخبار أسراه. وبموازاة رابطة عائلات الأسرى التي تقود حراك الشارع مطالبة بصفقة تقدّم أبناءها على سائر المصالح السياسية والأمنية، ثمّة أخرى تتبنى منطق "النصر المطلق" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى لو راح أبناؤها في سبيل ذلك، ومنهم، على سبيل المثال، والدة الأسير يوتام حاييم، الذي أقرّ الجيش بقتله خطأً في الشجاعية، حين خاطبت الجيش بأن "لا يتردد في إطلاق النار". حتى استطلاعات الرأي، قبل الأمس القريب، ظلّت تعطي أولوية لاستكمال الحرب، سوى في استطلاعَين أخيرَين أجريا خلال الشهرين الماضيين، مع اعتبار أن انعكاس النتائج هذا يأتي، كما عبر أحد المعلقين الإسرائيليين، وسط قناعة بأن عودة الأسرى تتيح استكمال الحرب بلا ضغوط.
ووراء كل هذا انزياح أيديولوجي عميق داخل المجتمع الإسرائيلي، لم تحدثه "صدمة" السابع من أكتوبر وحسب وإنما تعاليم جيلين من نسل التزاوج العنيف بين الدين والقومية؛ ومن حواصله اليوم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وترى هذه التعاليم في الفلسطينيين "عدواً فطرياً"، وفي الحرب فرصة، وفي الخراب بشرى، وفي الفداء ضرورة من أجل "الخلاص"، هذا ليس اعتقاداً شاذاً، بل عليه إجماع في أوساط الحاخامات (بالأخص الأشكناز الحريديم منهم)، والحركات الاستيطانية، وله تجليات في الإعلام والمجتمع، وكذلك في صلب السياسة الإسرائيلية الرسمية.
من انتظار الخلاص إلى استشرافه
يمكن القول إنّ الصهيونية برمتها قامت على انحراف أيديولوجي في العقيدة من "انتظار الخلاص" إلى "استشرافه"؛ بمعنى التسليم بأن الخلاص لن يتحقق ما لم يعمل "الشعب اليهودي" لاستحضاره، وظل هذا الانحراف ضمن حدود السياسة حتى حرب 1967. في تلك اللحظة التي بدت "معجزة" في الوعي الإسرائيلي العام، بدأ طيف من المتردّدين من اليهود الأصوليين يؤمن بأن إسرائيل تستشرف خلاصها. حينها شاعت تعاليم الحاخام الصهيوني تسفي يهودا كوك (أبوه هو الأب الروحي للصهيونية الدينية) بأن وصية "الغزو والاستيطان" الواردة في التوراة هي مكملة لسائر الوصايا في اليهودية، وأنها "التنقيح الواجب لتعجيل عودة المسيح"، الذي سيظهر مبشراً بـ"انتهاء معاناة الشعب اليهودي"، لكن هذا سيحدث فحسب بعد "تتمة استعادة كامل أرض إسرائيل من النيل إلى الفرات". ستصبح تلك التعاليم في صلب عقيدة حركة "غوش أمونيم" الاستيطانية، وفي إثرها "المنظمة السرية الصهيونية" التي خططت عام 1984 لنسف المسجد الأقصى بهدف إشعال المنطقة، أملاً في أن يكون بادئة "حرب يأجوج ومأجوج" التي "ستنتزع الشرور من العالم"، وتنتهي بظهور المسيح؛ قبل أن تكتشف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الخطة.
هذا الإيجاز كافٍ لفهم الخلفية الفكرية والعقائدية للصهيونية الدينية لمن يمسكون بمفاصل الحكم اليوم، ولمن يصوّت لهم ولمن يستوطنون في الضفة ويخططون لاستيطان غزة غداً، وأيضاً، لقسم وازن ممن يقاتلون في الجيش. الفارق اليوم، كما تلخصه المتخصّصة في الحركات المسيانية الصهيونية، راشيل فيلدمان، هو أن الممارسة انتقلت من صورة تفجير الأقصى إلى صورة الاقتحامات التي نراها في تواتر شبه يومي، في استحضار مستمر للشرارة التي أطلقها أرئيل شارون عشية الانتفاضة الثانية. فكرة "الاستيطان من أجل الخلاص" التي اعتنقتها "غوش أمونيم"، مثلاً، تشيع اليوم في أوساط الجنود المتحدّرين من الصهيونية الدينية الذين يقاتلون في القطاع، كما يرصد مراسل صحيفة "هآرتس"، عبارة "لا نصر من دون استيطان"؛ ونجدها محفورة في جدارية على ممر "نتساريم"، الذي استعادته إسرائيل بعد نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ومعه المنشآت التي تشي بوجود دائم.
"لا نصر من دون استيطان" كانت أيضاً عنواناً لمؤتمر استيطاني كبير انعقد في القدس المحتلة، في يناير/كانون الأول 2024، تحت رعاية الصهيونية الدينية وبمباركة سياسية تمثّلت في حضور عشرة أعضاء في الحكومة، بعضهم من "الليكود". في هذه الحالة وحدها ما يكفي من الإشارات إلى مدى تغلغل ما كانت يوماً "عصابات سرّية" و"منظمات محظورة" في قلب السياسة والمجتمع الإسرائيليَين، ومعها الرؤى المسيانية القاضية، مفهوماً، بأن "الخلاص يُنتزع باليد". أحد منظّمي المؤتمر، مثلاً، كان أوزي شارباف، وهو حاخام وريادي استيطاني يعرفه جيداً أهل الخليل الذين تُسرق بيوتهم في وضح النهار بحماية من جنود الاحتلال. هذا الشخص كان من أعضاء "المنظمة السرية الصهيونية" ذاتها، التي خطّطت لتفجير الأقصى وفي سجلّه حكم بالسجن المؤبد من محكمة إسرائيلية.
في المؤتمر ذاته، تناغم المتحدثون، ومنهم بن غفير وسموتريش، على مفردات من قبيل "التضحية" و"الخلاص"، وأيضاً "العودة إلى غزة". أحد هؤلاء المتحدثين كان رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" في الخليل، إلياهو ليبمان، وهو والد أسير في غزة، لكنه خلال كلمته، التي امتدت لسبع دقائق، لم يأتِ على ذكر ابنه واكتفى بالقول: "نستذكر هنا كل من ضحوا، كل من قتلوا وجرحوا وخطفوا، من أجلهم نعود لاستيطان غزة وشمال الضفة". ثم مضى ليدعو إلى طرد سكان غزة: "ليس هناك أبرياء"، وألبسهم صورة "العماليق"، التي استدعاها نتنياهو في أول الحرب، وانتهى بالدعاء بأن "يزكي الرب جنودنا لتحقيق الخلاص على اتساع رقعة أرضنا، من نهر النيل إلى الفرات، ومن البحر إلى الصحراء، ثم ظهور المخلِّص (المسيح)، وبناء الهيكل".
تهليل للكارثة
تلك الرؤى الخلاصية ليست مجرد نجوى أو توسلات، بل قناعة تتردد يومياً في خطب الحاخامات. قبل بضع أيام فقط، نشر الحاخام زمير كاهان، رئيس منظمة "هيدبروت"، التي تملك قناة تلفزيونية وموقعاً يعمل بست لغات، مقطع فيديو بهدف "توعية شعب إسرائيل حول ما ينتظره ويُنتظر منه في اللحظة الراهنة"، ويقول الفيديو: "نحن نوجد في فترة ما بعد عام ونصف العام من الهزّات التي مرّ بها شعب إسرائيل... علينا ألّا ننظر إلى الأمور من ضيق الواقع الذي نعيشه، ولا إلى التاريخ من اللحظة الزمنية الراهنة، بل أن ننظر نظرة كلّية إلى أيام المسيح والخلاص والمستقبل. القلب يتراقص فرحاً (...) الأمر يشبه أن تولد في مغارة مظلمة وفي آخرها ضوء يتلألأ".
هذا التهليل النشواني للكارثة، وهو في جوهر عقيدة الخلاص الصهيونية، يتكرر أيضاً في خطبة لرئيس مجلس حاخامات التوراة، يتسحاك يوسف، الذي حرم "المبالغة في الندب والحداد على الميت"، غامزاً من قناة القتلى والأسرى، ثم خلص إلى أن "إسرائيل كانت بحاجة إلى كارثة حتى تعيد إحياء ذاتها"، الرسالة ذاتها تتردّد في حديث الحاخام دوف ليور، وهو أحد القيادات الدينية المخضرمة في إسرائيل، إذ يقول "إن الحرب في غزة هي مرحلة في خلاص إسرائيل، ويجب أن ننظر إليها باعتبارها جزءاً من التدبير الإلهي للعودة إلى صهيون". يتفق آخر، اسمه يوسف بيطون، في أن الحرب الحالية "حدث يتدحرج إلى حرب يأجوج ومأجوج، التي ستغير الوضع على صعيد عالمي"، ويدلل على ذلك مستشهداً لا في التوراة بل في كتب المفسرين (تحديداً الحصون)، بأن "النصوص أخبرتنا عن أن حرب يأجوج ومأجوج ستأتي من مملكة إسماعيل، وهذه أولى مراحلها، ثم يكون هناك اقتتال مع ملك الفرس، وهذه ستصبح حرباً عالمية ثالثة".
تلك الأصوات، وإن بدت للوهلة الأولى ناشزة، تجد أصداء في قلب المؤسسة العسكرية وفي أوساط من يخوضون قتالها في غزة. يتقمص الحاخام في الجيش الإسرائيلي أفيخاي فريدمان النشوة ذاتها، في أعقاب أهوال السابع من أكتوبر وما تلى من مشهدية الإبادة في القطاع، قائلاً: "أجد نفسي أمام أسعد شهر في حياتي (...) لأننا اليوم نسمو شعباً إلى درجة جديدة، وندرك أخيراً من نحن. هذه الأرض لنا، كلها؛ سنستعيد غزة، ولبنان، وكل الأرض الموعودة". تبعاً لذلك، تجد تلك الأصوات أصداء داخل مؤسسة الحكم، من توصيف نتنياهو الفلسطينيين بـ"العماليق"، إلى استطراد وزيره سموتريتش ما حبسه نتنياهو من السياق التوراتي: "محو ذكرى العماليق من تحت كل سماء (في درب استعادتهم الأرض الموعودة)"، مروراً بحديث وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو (وفي سجلّه، كما في سجلّ سموتريتش، شهادة أن حياة الأسرى ليست أغلى من حياة الجنود) عن أن "الخلاص يتجلّى أمام عيوننا"، وصولاً إلى ترديد وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، أن المقتلة القائمة "هي حرب يأجوج ومأجوج".
بين مسيح بن غوريون ومسيح نتنياهو
ما المختلف اليوم إذاً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الصهيونية قامت في الأساس على المخيال المسياني ذاته؟ نستعيد ما قاله بن غوريون، غداة قيام الدولة العبرية، إجابة على سؤال عن الوصايا التوراتية وما تمليه على السياسة الإسرائيلية: "الشعب اليهودي اليوم يعيش أيام المسيح عبر توقعه والإيمان به، وهذا هو السبب الجوهري لوجود الشعب الإسرائيلي". يُسقط بن غوريون واقعيته السياسية على المثاليات التوراتية، وعلمانيته على العقيدة، حينما يرى أن "الخلاص" يتمثل في السعي لا الوصول، وأن "المخلص" هو "شعب إسرائيل" لا أنبياؤه المنتظرون، وأن "المسيح" هو اللحظة الراهنة لا النبوءة المنتظرة. معنى ذلك أن ما تقتضيه المصلحة العليا، إن كان حدوداً أقل أو أزيد، سلاماً أو حرباً، تنازلاً أو مقايضة؛ كل ذلك لا يغيّر حقيقة أن "شعب إسرائيل" يعيش "خلاصه"، بل إنه يتحراه على ضمنيته، في سيرورة لا تنتهي.
أما في زمن نتنياهو، الذي أخبره مستشاره الروحي مناحيم شنييرسون قبل أن يصبح رئيساً للوزراء أنه هو من سيسلم الصولجان إلى المسيح، فالمسافة بين الأمس واليوم هي المسافة ذاتها بين براغماتية الصهيونية التقليدية وأيديولوجية نظيرتها اليمينية، في نسختها الأكثر أصولية، ممثلة بمؤسسة الحكم الحالية. لا يرى هؤلاء في المسيح حقيقة متقمصة، ملتبسة ومتغيرة، وإنما "حتمية" تاريخية منتظرة، تمليها النصوص الموروثة، وهي إذاً لا تتنزل إلا بمزيد من المعاناة ومن الخراب والدم ضمن حرب شاملة، يكون فيها "النصر مطلقاً" ضد عدو تصوره النصوص المسيانيّة ذاتها على أنه "شرير بالفطرة"، وينبغي "محوه" من أصغره إلى أكبره (كالعماليق)؛ والأخطر هو القناعة ببواجب استجلابها، بانتزاعها العنيف من النبوءة إلى الواقع. هذا ما يغذي سادية كل تلك الانتهازية النشوانية للكارثة، والقناعة الكامنة، التي انحرف لسان وزيرين عن كتمانها، بأن الأسرى، ومعهم الجنود، هم قرابين على مذبح الفداء والشهوة المتفتّحة على مشهدية الخراب في غزة لـ"إعادة استيطانها وجعلها تزهر من جديد"، وهذا اقتباس عن سموتريتش ورئيسة جمعية "نحالاه" الاستيطانية دانيلا فايس، وجندي عابر في غزة كان يشارك مقطع فيديو من بين "خرائب رفح" على مواقع التواصل، وفوقهم جميعاً سليل الصهيونية المسيحية، دونالد ترامب، على حد سواء.


.png) 6 days ago
3
6 days ago
3

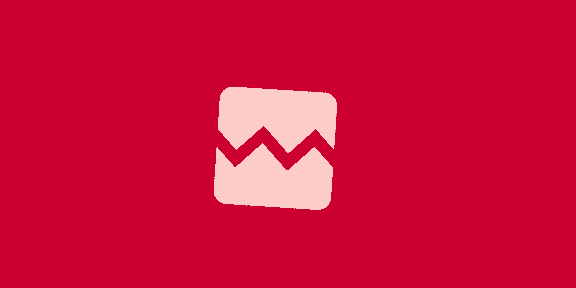








 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·