ARTICLE AD BOX
في أول زيارة خارجية له خلال ولايته الرئاسية الثانية، اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية، إذ يسعى من خلالها إلى توقيع اتفاقية تتيح للرياض استثمار أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، تشمل صفقات ضخمة في مجال المعدات العسكرية. ومن المتوقع أن تُبرم اتفاقيات مماثلة مع كل من قطر والإمارات. وتُظهر هذه الزيارة أنها تتجاوز مجرد البعد الاقتصادي، في ظل التحولات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة.
وفي الوقت الراهن، تشهد العلاقات السعودية الأميركية تطوراً ملحوظاً، إذ تسعى الرياض إلى ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة مع واشنطن تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ومع ذلك، تحرص المملكة على الحفاظ على استقلالية موقفها تجاه ملف التطبيع مع إسرائيل، وهو الملف الذي ما زال يُعدّ نقطة خلاف جوهرية بين الجانبَين.
تُصر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن التقارب بين السعودية وإسرائيل يجب أن يكون جزءاً من اتفاق شامل يُعزز موقع التحالف الأميركي في الشرق الأوسط. في المقابل، ترى الرياض أن الجمع بين هذه الملفات قد يُلحق ضرراً بمصالحها الاستراتيجية ويُضعف من مصداقيتها على الساحتَين العربية والإسلامية، خاصّة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.
ومنذ ولاية ترامب الأولى، ولاحقاً خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تبذل الولايات المتحدة جهوداً متواصلة للتوصل إلى اتفاق يُفضي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وقد خاضت الرياض وواشنطن مفاوضات مطوّلة حول هذا الملف، إذ ربطت المملكة إمكانية التطبيع بمجموعة من الشروط التي تعتبرها ضرورية لضمان أمنها القومي وتعزيز دورها الإقليمي.
خلال مسار مفاوضاتها مع الإدارة الأميركية بشأن إمكانية التطبيع مع إسرائيل، تمسكت السعودية بشرط جوهري يتمثل في الحصول على التزام واضح – ولو كان رمزياً – من الجانب الإسرائيلي بالانخراط في مسار سياسي يؤدي إلى حل الدولتَين وإنهاء الاحتلال. غير أن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا المطلب قطعاً، وأعلنت في مناسبات عدّة رفضها الصريح لأي حديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في الوقت الذي واصلت فيه توسيع مشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية.
هذا التعنّت الإسرائيلي، إلى جانب التحولات التي شهدتها المنطقة عقب اندلاع حرب غزة، والتصعيد العسكري واسع النطاق من جانب إسرائيل، وما صاحب ذلك من اتهامات دولية بارتكاب جرائم تهجير قسري بحق الفلسطينيين، أسفر عن تحول واضح في الموقف السعودي. فبعد أن كانت المملكة حريصة على تجنب أي صدام مباشر مع إسرائيل، بدأت مواقفها تأخذ منحى أكثر تشدداً، وظهرت في خطابها الرسمي وغير الرسمي نبرة تحفّظ متزايدة تجاه فكرة التطبيع.
يمكن القول إنّ احتمالات توقيع اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه سابقاً، خصوصاً في ظل تمسك الرياض بالفصل بين مصالحها الاستراتيجية مع واشنطن وبين الضغوط المرتبطة بتطبيع العلاقات مع تل أبيب، ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عاد هذا الملف إلى الواجهة مجدداً، لكن ضمن ظروف إقليمية وسياسية أكثر تعقيداً.
وتحاول الإدارة الأميركية استغلال رغبة السعودية في تطوير قدراتها النووية لأغراض سلمية، وسيلةً للضغط عليها من أجل دفعها نحو توقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل. وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بزيارة إلى الرياض، وهي زيارة يُرجّح أن تتجاوز الجوانب الاقتصادية وصفقات الدفاع، خاصة وأن ترامب كان قد تعهد خلال ولايته الأولى بتوسيع دائرة اتفاقيات أبراهام، وهي سلسلة اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل وعدد من دول الخليج. وفي هذا السياق، عبّر ترامب عن ثقته في أن المملكة ستنضم إلى هذه الاتفاقيات، وذلك في تصريح أدلى به خلال مقابلة مع مجلة "تايم".
ترى الرياض أن الجمع بين الملفات قد يُلحق ضرراً بمصالحها الاستراتيجية ويُضعف من مصداقيتها على الساحتَين العربية والإسلامية
غير أن هذا التصريح يقابله تشبث المملكة بموقفها من التطبيع، وربطه بمجموعة من المطالب والشروط الضامنة لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وسبق لوزارة الخارجية السعودية أن أصدرت بياناً جاء رداً على أحد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاء فيه أنّ "المملكة العربية السعودية أوضحت أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يجرِ إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وأضاف البيان ذاته أن "المملكة العربية السعودية ترفض بشدة أي انتهاك لحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع المستوطنات الإسرائيلية وضم الأراضي وجهود التهجير".
في ظل هذا التباين في المواقف بين البلدَين في ما يخصّ ملف التطبيع، تشير التقديرات إلى أن الجانب السعودي سيحرص خلال هذه الزيارة على إبلاغ ترامب برغبته الأكيدة في تعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة، لكن دون ربط ذلك بأي اتفاق تطبيعي مع إسرائيل، خاصّة بعد ما أصبحت الرياض ترى أن مثل هذا الاتفاق غير قابل للتحقق في الظروف الراهنة.
غير أنه من المنتظر أن تحضر القضية الفلسطينية بقوة في جدول النقاشات خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الرياض، خاصة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والضغوط الدولية المتزايدة لإيجاد تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ورغم إصرار ترامب على تقديم نفسه بوصفه يسعى إلى "حسم" هذا الملف، إلّا أن تجارب الماضي القريب تثير الكثير من الشكوك حول مدى قدرته، أو رغبته الحقيقية، في تقديم حلول عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية.
فخلال ولايته الأولى، لم يُخفِ ترامب انحيازه الصريح لإسرائيل، بل ترجم ذلك بقرارات جوهرية غيّرت من طبيعة الدور الأميركي التاريخي في عملية السلام، وعلى رأسها إعلانه عام 2017 الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في خطوة أحادية الجانب وصفها بأنها "متأخرة جداً" لدفع العملية السلمية. غير أن هذه الخطوة اعتُبرت من الكثيرين، وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إعلاناً رسمياً بانسحاب الولايات المتحدة من موقعها وسيطاً في المفاوضات، وتقويضاً لأسس الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية.
اليوم، وبعد أن زادت السياسات الإسرائيلية تطرفاً، وتراجعت فرص حل الدولتَين إلى أدنى مستوياتها، يعود ترامب إلى المشهد محاولاً لعب دور فاعل في الملف الفلسطيني، دون أي مراجعة لسياسته السابقة أو تقديم ضمانات جديدة تعيد شيئاً من التوازن. وهنا تبرز مفارقة عميقة: كيف يمكن لرئيس أثبت انحيازه الكامل لإسرائيل أن يقود جهود "الحسم" في قضية تتطلب أعلى درجات الحياد والعدالة؟ هل هو تسوية شاملة تضمن للفلسطينيين حقهم المشروع في إقامة دولتهم، أم مجرد صيغة جديدة لفرض أمر واقع يخدم أجندة إسرائيلية تحت عنوان "السلام الإقليمي"؟
في ظل هذه المعطيات، يبدو أن أيّ دور لترامب في مستقبل القضية الفلسطينية سيكون محل جدل واسع، ليس بسبب مواقفه السابقة فحسب، بل أيضاً بسبب غياب الثقة الفلسطينية والعربية في حياده ونزاهته وسيطاً، والواقع أن رؤية ترامب لحل ملف القضية الفلسطينية، لن يكون مقبولاً عربياً، خاصة في الرياض، إذا لم يتضمن اعترافاً صريحاً بحقوق الفلسطينيين، والتزاماً حقيقياً بحل الدولتين، وهو ما يبدو بعيد المنال في ظل الظروف الحالية.

.png) 1 week ago
12
1 week ago
12

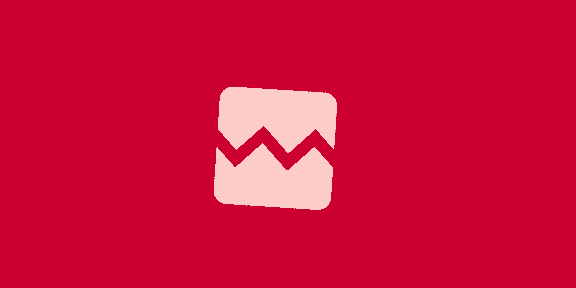









 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·