ARTICLE AD BOX
هل تصعّد الصين لأنها تزداد قوة، أم لأن منافسيها ينهارون؟ تعقيباً على الحرب التجارية الحالية، كتب سامر خير أحمد في مقاله "الصين سعيدةٌ بما يفعله ترامب" ("العربي الجديد"، 14/4/2025) "ربّما لا يُعبّر ردّ الصين على فرض رسوم جمركية أميركية بفرض رسوم جمركية صينية عن غضب إزاء كرامتها الوطنية... بقدر ما يُعبّر عن تشجيعها ترامب وإدارته على المضي في هذه الإجراءات، وعدم التراجع عنها". لا يبدو أن صعود الصين فقط ما يصنع لحظتها، بل هشاشة الآخر أيضاً.
وتعكس الفجوة بين واشنطن وبكين تبايناً عميقاً في نمط القيادة السياسية واحترام هيبة الدولة، ففي حين تميل الرئاسة الأميركية، لا سيّما في عهد دونالد ترامب، إلى التفاعل اللحظي "التغردائي" والشعبوية الرقمية، تقدّم الصين نموذجاً لقيادة مركزية تقليدية أكثر انضباطاً وتمسّكاً بالهيبة الوطنية. ترامب، الذي تحوّلت تصريحاته وخطاباته مادةً يوميةً للتداول والسخرية في وسائل التواصل الاجتماعي، قدّم صورة لرئيس يتصرف "ناشطاً رقمياً"، يختزل قضايا السياسة الدولية بمعادلة "أنا الدولة والدولة أنا".
لا يستند صعود بكين إلى تطورها الذاتي فقط، بل يمرّ أيضاً عبر التآكل التدريجي لمكانة واشنطن
شي جين بينغ: سلطان الأمة
منذ اندلاع الحرب التجارية، برز الرئيس شي جين بينغ قائداً راسخاً يجسّد تقاليد الدولة الصينية في المركزية والانضباط. لم يكن إدراج "فكر شي" ضمن الدستور الصيني حدثاً عابراً، بل شكّل تتويجاً لدوره قائداً صاحب رؤية متكاملة ومؤسَّسة. وبينما يستقبل شي في العواصم الآسيوية بالسجاد الأحمر، يتعرّض ترامب للانتقادات الساخرة حتى داخل الدوائر الغربية.
يحترم شي مفهوم هيبة الدولة ويسعى لتحقيق "سلطان الأمة" الصينية، فلا يتعامل مع موقعه بصبيانية، ولا يجعل نفسه عرضةً للهجوم أو الإرباك في وسائل التواصل، كما أنه يتجنّب القرارات الارتجالية وردّات الفعل الانفعالية التي قد تسيء إلى شخصيته ومكانة بلاده. كذلك يقول هانس مورغنثاو، في كتابه الشهير "السياسة بين الأمم"، إن "السياسة الدولية هي صراع من أجل السلطان"، والسلطان، بحسب مورغنثاو، يتمثّل في السيطرة على عقول الآخرين وأفعالهم، ما يجعل البحث عن المكانة ركيزةً أساسيةً لسلوك الدولة. ومن أسس الحفاظ على هذه المكانة ضبط النفس، كما تفعل الصين. ومن الخطأ، كما يحذّر مورغنثاو، "اعتبار السياسة الدولية مجالاً للهو الشخصي،" كما يفعل ترامب حين يسعى لتمجيد دولته عبر إذلال الآخرين واستعراض تفوقه الشخصي. فمثل هذا السلوك في السياسة الخارجية "يشبه اللعب بالنار، التي قد تحرق صاحبها إذا لم يكن يملك القوة التي تتناسب مع مظاهره الاستعراضية". يتجلّى هذا التناقض في أداء ترامب خلال الحرب التجارية، إذ صرّح في أحد خطاباته قائلاً: "كانت الدول الأخرى تتودّد إليّ وتلهث (استخدم لفظاً فظاً) للتفاوض معي بشأن الرسوم الجمركية قبل دخولها حيز التنفيذ"، لكنّه سرعان ما تراجع عن هذا التبجّح، مُلمّحاً إلى احتمال خفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية "بشكل كبير من دون أن تصل إلى الصفر"، ومن دون أن تلهث الصين، كما كان يتصوّر.
الغوغائية التي تعامل بها ترامب مع السياسة الدولية أسهمت في دفع دول عديدة لإعادة النظر في علاقاتها مع الصين، التي تقدّم نموذجاً مغايراً يقوم على الاحترام المتبادل، بغضّ النظر عن حجم الدولة أو وزنها السياسي. تلتزم الصين بسلوك دبلوماسي رفيع يظهر بوضوح في بروتوكولات الاستقبال والزيارات الرسمية، ما يمنحها رصيداً متنامياً من القوة الناعمة. في المقابل، فإن افتقار واشنطن إلى التوازن في مواقفها، وتجاهلها أبسط قواعد اللياقة السياسية، أضعف من صورتها الدولية. يكفي تأمل مشاهد اللقاءات الثنائية في البيت الأبيض، حيث يُوضع رؤساء الدول على ما يشبه "كرسي الاعتراف" محاطين بالصحافيين في غرف ضيقة، لتدرك الفارق.
على النقيض، تلتقط الصين صوراً رسمية تقليدية إطارها عريض، يظهر فيها الرئيس شي واقفاً جنباً إلى جنب مع قادة الدول الأخرى، في مشهد يعكس الاحترام والمساواة، بغضّ النظر عن مستوى العلاقات أو توازن القوى بين الطرفَين.
صعود الصين ليس مجرّد قصّة نموّ ذاتي، بل تفاعل مع انحسار الدور الأميركي في النظام الدولي
من الاحتواء إلى ردّ الاحتواء
عندما أطلقت واشنطن في عام 2008 استراتيجية احتواء الصين، عبر بناء تحالفات أمنية واقتصادية في آسيا، لم تتوقّع أن ترتدّ هذه الأداة عليها. اليوم، تبني بكّين بهدوء وفعّالية شبكة احتواء مضادّة، من دون أن تعلن ذلك صراحة. هي لا تحاصر الدول، بل تجذبها عبر المصالح. لا تواجهها مباشرة، بل تقنعها اقتصادياً. الأكثر أهمية، أن الدول التي اعتمدت عليها واشنطن لاحتواء الصين أصبحت اليوم أقرب إلى بكين، بسبب تداعيات الحروب التجارية الأميركية، ما يجعل من "الاحتواء العكسي" استراتيجية صينية غير معلنة، ولكن فعّالة، تجسّدت أخيراً في إعلان الصين تحديث اتفاقية التجارة الحرّة مع دول آسيان (دول جنوب شرق آسيا).
الدول التي فرضت عليها واشنطن تعريفات جمركية هي نفسها التي استخدمتها منذ 2008 لاحتواء بكين. فعسكرياً، بنت واشنطن تحالفات، مثل الحوار الأمني الرباعي (كواد) مع اليابان (24% تعريفات)، وأستراليا (10%)، والهند (26%). كذلك أنشأت تحالف أوكوس مع أستراليا. أمنياً، عزّزت واشنطن صفقات السلاح مع دول متنازعة مع الصين في بحر الصين الجنوبي، مثل فيتنام (46% تعريفات)، الفيليبين (17%)، وتايوان (32%)، وماليزيا (24%). سياسياً، دفعت واشنطن بعض الدول، مثل الفيليبين، إلى مقاضاة الصين أمام محكمة العدل الدولية حول النزاعات البحرية. أمّا اقتصادياً، فإلى جانب تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية، مارست ضغوطاً لمنعها من الانخراط مع مبادرات الصين، مثل طريق الحرير وبنك التنمية الآسيوي، ولكنّها فشلت في أغلب الحالات.
استغلّت الصين الحرب التجارية، إذ بداية عرضت خطّةً لـ"التعاون المشترك" مع أستراليا في مواجهة الحرب التجارية، وردّ نائب رئيس الوزراء، ريتشارد مارليس، عليها بالرفض قائلاً: "لن نتعاون مع الصين في أيّ صراع عالمي، لن نفعل ذلك". ولكن أستراليا الحالة الوحيدة التي رفضت مباشرة، ورغم ذلك، اتجهت بقية الدول الآسيوية إلى تعزيز علاقاتها مع بكين لمواجهة تداعيات التعريفات.
على مستوى أكبر، دفعت التعريفات الجمركي اليابان وكوريا الجنوبية (أهم حلفاء واشنطن في آسيا) إلى عقد أول حوار اقتصادي لهم لتسهيل التجارة الإقليمية بعد انقطاع لأكثر من خمس سنوات. ووفقاً للبيان الصادر عن الدول الثلاث، اتفقت على "التعاون الوثيق لإجراء محادثات شاملة ورفيعة المستوى بشأن اتفاقية تجارة حرّة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، لتعزيز التجارة الإقليمية والعالمية"، عبر تسريع المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارة حرّة بينهم، والتي لم تُسفر عن أيّ نتائج ملموسة منذ بدء المفاوضات عام 2012. وهو تطوّر يدلّ على أن التعريفات الجمركية أدّت، بعكس نيات ترامب، إلى تقارب أكبر مع بكين.
في جنوب شرق آسيا، وجّهت ماليزيا دعوةً إلى الرئيس الصيني لزيارتها في إبريل/ نيسان، انتهت بنشر بيان مشترك من 56 نقطة، جوهره تعزيز التبادلات التجارية بين الطرفين، ورفض الحرب التجارية. وبذلك، من الممكن أن تفقد واشنطن قدرتها مستقبلاً في دفع ماليزيا إلى مواجهة الصين، وسيزداد النفوذ الصيني داخل الأسواق الماليزية. فيتنام كذلك، رغم خلافها التقليدي مع الصين، تلقّى شي دعوة لزيارتها، وعقدت في نيسان، ووصفها الرئيس الفيتنامي لونغ كونغ بأنها "تاريخية". لقد طرح لونغ موقفاً من بكين يتناقض تماماً مع واشنطن، مؤكّداً أن الصين تحتلّ "أولويةً قصوى" في السياسة الخارجية لفيتنام، وعبّر عن دعمه الكامل لمواقف الصين تجاه قضايا شينجيانغ، وهونغ كونغ، وتايوان. وقال: "تتمسّك (فيتنام) بثباتٍ بسياسة الصين الواحدة، وتعارض بشدةٍ الأنشطة الانفصالية الساعية إلى استقلال تايوان... وتعارض أيّ تدخّلٍ من قوى خارجية في الشؤون الداخلية للصين".
أمّا الفيليبين، التي فرضت عليها تعريفات أقلّ (17%) مقارنةً بغيرها من دول آسيان، فقد أبدت مواقف متحفّظة. فعلى الصعيد الرسمي، أشارت إلى أن التعريفات ستكون عائقاً أمام إتمام صفقات السلاح مع أميركا. إلا أن هناك أصواتاً فيليبينية نادت بضرورة إيجاد "طرق للتعامل مع الصين استراتيجياً للتغلّب على تداعيات التعريفات الجمركية". ومستغّلاً التعريفات الجمركية، عرض السفير الصيني في الفيليبين، هوانغ شيليان، مقترحاً دفع الفيليبين للعمل مع الصين لمواجهة التعريفات وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية الفيليبينية للدراسات الصينية، لوسيو بيتلو: "من المرجّح أن تزيد الرسوم الجمركية من أهمية اتفاقيات التجارة الحرّة الإقليمية، حيث ستتكاتف الدول لتنويع سلاسل التوريد، وهذا بدوره سيساعد في تسريع إبرام اتفاقية الصين-آسيان المُحسّنة، وتعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة". وقالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة الفيليبينية سابقاً، رافاييلا ألدابا، "على الفيليبين العمل مع الصين وجيرانها من دول آسيان للتحوّط من صدمات التعريفات الجمركية العالمية، وتحوّلات سلاسل التوريد - استراتيجياً وانتقائياً".
تايوان، في المقابل، بحكم طبيعة الصراع مع الصين، سلكت مساراً مغايراً؛ إذ سعت لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة تحت شعار "تايوان زائد واحد"، أي تايوان زائد الولايات المتحدة، وقالت إنها لن تفرض تعريفات جمركية انتقامية في المقابل. وعقدت مرحلة أولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول التعريفات الجمركية، وقامت واشنطن بتعليق جميع الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات تمهيداً لبدء المحادثات.
أحد أكبر أخطاء واشنطن أنها لا تترك للدول فرصةً لفهم طبيعة الصعود الصيني، بل تدفعها دفعاً نحوه
صعود عبر هبوط
ليس صعود الصين مجرّد قصّة نموّ ذاتي، بل تفاعل مع انحسار الدور الأميركي في النظام الدولي، فبينما تسعى بكين إلى تعزيز نفوذها بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الشعبية عام 2049، فإن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد على تعاظم قوتيها الاقتصادية والعسكرية فقط، بل أيضاً استثمار تراجع واشنطن، كما وصفه جيف كولغان بـ"الهيمنة الجزئية".
تدرك الصين أن شرعية صعودها تمرّ عبر قبول المجتمع الدولي لها. لذا، تخوض معركةً سرديةً تسعى فيها إلى إعادة تعريف مفاهيم الهيمنة والعدالة الدولية. في المقابل، لا تبدي واشنطن اهتماماً فعلياً بإعادة إنتاج صورتها، خلافاً لما فعلته خلال صعودها في القرن العشرين حين قدّمت نفسها قوةً مناهضةً للاستعمار، مستندةً إلى مبادئ ويلسون والنقاط الأربع عشرة. أمّا اليوم، فالصين هي من تعيد صياغة تلك المبادئ بمضمون مضادّ، مروّجةً نموذجاً عالمياً بديلاً، يُفترض أنه أكثر عدالةً. وتسعى بكين من خلال هذا التوجّه إلى كسب قبول رمزي واستراتيجي، يمكّنها من الانتشار في "رقعة الشطرنج الكبرى"، كما وصفها زبغنيو بريجنسكي في التسعينيّات حين توقّع أن تكون الصين من أبرز تحدّيات الهيمنة الأميركية المستقبلية.
لذلك، وكما هي صيرورة التاريخ، لا تصعد قوة إلا بهبوط أخرى. فصعود بكين لا يستند إلى تطورها الذاتي فقط، بل يمرّ أيضاً عبر التآكل التدريجي لمكانة واشنطن. وبغضّ النظر عن نيات الصين أو سياساتها، اتفقنا معها أم لا، فإن العالم يتعامل اليوم بردّة فعل على السلوك الأميركي الفجّ، ويرى في الصين بديلاً. وربّما يكمن أحد أكبر أخطاء واشنطن في أنها لا تترك للدول فرصةً لفهم طبيعة الصعود الصيني، بل تدفعها دفعاً نحوه.


.png) 1 week ago
6
1 week ago
6


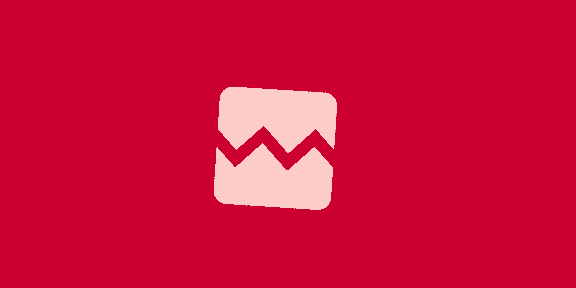








 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·