ARTICLE AD BOX
في صمت المكاتب الفارهة حيث تُنسج القرارات، وبين ضجيج الشوارع التي تئن من سوء الخدمات، يتسلل سؤال ثقيل: هل الفساد هو فيروس يغزو الأجساد الحاكمة من الخارج، أم أنه نسيج خفي في قلب المؤسسات تم قبوله وشرعنته حتى أصبح جزءًا من تعريف السلطة ذاتها؟
من السهل دائماً شيطنة الفساد السياسي، وربما هذا ما يجعلنا نشعر بالراحة عند الحديث عنه كأننا نحارب وحشاً خارجياً غريباً عن أجسادنا. لكن الفساد، بكل تجلياته، لا يأتي من المجهول. بل إنه في كثير من الأحيان نتاج ثقافة داخلية، جزء من معمار النظام، لا نبتة شيطانية سقطت من السماء، بل بذرة زرعها الطمع وسقتها الأعراف ونمّاها الصمت الشعبي.
الفيروس أم النظام؟
تشبيه الفساد بالفيروس شائع في الخطاب الإعلامي والسياسي، وربما مريح أيضاً. الفيروس يدخل من الخارج، يهاجم، ويُقابل بالمقاومة. هذا النموذج يظهر السياسي الفاسد كمخلوق شاذ خرج عن طاعة النظام ويجب عزله أو محاكمته. يتم تقديمه كخائن للقيم، بينما يُفترض أن القيم ما زالت نقية. لكن ماذا لو كانت القيم نفسها فاسدة؟ ماذا لو كانت المؤسسة كلها قائمة على تواطؤ صامت يتيح للفساد أن يكون هو الأصل لا الشاذ؟
هنا يصبح تشبيه الفساد بالفيروس إهانة للذكاء الجمعي. فالفيروس يتطلب مناعة كي لا يتمكن من الجسد، أما الفساد فيعيش في جسد بلا مناعة أو ربما في جسد يعتقد أن المرض جزء من الصحة.
الفساد ليس فيروساً يغزو المؤسسات من الخارج، بل هو بذرة زرعها الطمع وسقتها الأعراف ونمّاها الصمت الشعبي حتى أصبحت جزءاً من تعريف السلطة
الفساد: سلوك فردي أم نظام مؤسسي؟
عندما يتحول الفساد من سلوك فردي إلى ممارسة يومية، وعندما يصبح جزءاً من لغة التعامل السياسي كرشوة، صفقة، منصب مقابل الولاء، عقود مقابل الصمت، فإننا نكون أمام منظومة، لا مجرد أفراد.
هنا لا يكون الفساد مرضاً طارئاً، بل يكون هو النظام الحقيقي خلف الستار. المؤسسة لا تعترف به رسمياً، لكنها تعتمد عليه فعلياً. المسؤول لا يُقال لأنه فاسد، بل يُقال لأنه لم يحمِ شبكته جيداً. من يحسن إدارة الفساد يُكافأ، ومن يفشل يُفضح. هكذا يتحول الفساد إلى نوع من الاحتراف في دوائر الحكم، بل إلى معيار للكفاءة أحياناً. وهذه هي المصيبة الكبرى.
الفساد والتواطؤ الشعبي
من الناحية النفسية والاجتماعية، فإن الشعوب لا تسكت عن الفساد عبثاً، بل هي تتواطأ أحياناً وأحياناً تُهزم. السكوت هنا ليس فقط خوفاً، بل أيضاً نوعاً من الاعتياد. العرف المؤسسي لا يتكون في الفراغ، بل يتغذى على الذاكرة الجمعية والخِيبة المتراكمة.
حين يرى المواطن أن الشريف يُهمش وأن الكفاءة تُقصى، بينما يُكافأ المنافق والانتهازي، فإن بوصلته الأخلاقية تبدأ بالاختلال. من هنا تتكون فلسفة الفساد، ليس كقيمة أخلاقية، بل كمنطق براغماتي للبقاء. فيسأل المواطن نفسه: (لماذا أكون نظيفاً في نظام لا يكافئ إلا القذرين؟)
وبينما الإجابة دائماً مؤلمة، يفضل أن يصمت المواطن أو يساير.
تفكيك المنظومة: الحل الوحيد
كسر هذا العرف لا يكون بالمواعظ ولا بالشعارات. إنه يتطلب تفكيكاً عميقاً للمنظومة يبدأ من فهم أن الفساد ليس مجرد خلل، بل هو هيكل. مقاومته تتطلب إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة، وإعادة الاعتبار للقيم التي صارت تُمارس كترف أخلاقي لا كضرورة بنيوية للدولة والمجتمع. فلا يمكن محاربة الفساد بإحلال فاسد مكان فاسد، ولا بإنتاج خطاب عدائي ضد الأشخاص بينما يُترك البناء كما هو. بل يجب أن تتغير البنية، ويُعاد تعريف السلطة بوصفها خدمة لا امتيازاً.
أهمية القانون والتغيير الجذري
هنا تأتي أهمية القانون، الذي يجب أن يكون ليس كنص بل كقوة نافذة على الجميع. فلا يكفي أن نكتب قوانين ضد الفساد بل يجب أن نمنح المواطن الثقة بأنه يمكنه أن يبلغ ويُحاسب ويُصدق.
الفساد: النظام نفسه
الفساد السياسي هو النظام نفسه في الكثير من البلدان مع الأسف. فهو نظام خفي يدير المشهد من وراء الكواليس، حيث تصبح الوظيفة السياسية لا وسيلة للبناء بل أداة للنهب المنظم. حين يُصبح الفساد عرفاً، نكون قد عبرنا من مرحلة المرض إلى مرحلة التعايش معه، والتطبيع مع نتائجه، إلى الحد الذي نبدأ فيه بانتخاب الفاسدين عن وعي لا عن جهل.

.png) 5 hours ago
2
5 hours ago
2

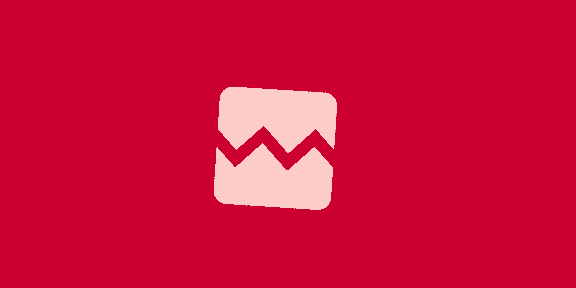









 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·