ARTICLE AD BOX
ربما وجب الانطلاق من فكرة جوهرية أساسية تَعْتَبِر أن ما سمّي في المغرب "المسلسل الديموقراطي" في سنة 1975، والذي، فيما يبدو، نسخ حالة الاستثناء المفروضة بنصّ دستوري قبل ذلك بعشر سنوات، هو محور التحوّلات العامة التي عرفها المغرب، منذ ذلك الوقت، على امتداد نصف قرن من الزمن الاجتماعي والسياسي، بما كان فيه من أوضاع وصراعات وتحوّلات وتراكمات أيضاً. وسأعرض محتوى "المسلسل" المذكور وأهميته، من خلال بناء نظري، أعرض محتواه في النقاط التالية:
الأولى، أنه شرّع للعملية الانتخابية في ظروف متجددة زاد فيها عدد السكان، رغم مظاهر التزوير وتحقير الإرادة الشعبية التي شابت العمليات على امتداد مرحلة طويلة. والثانية، لأنه فتح أمام النخب المختلفة في المدن بصورة خاصة، وأمام الأعيان في البوادي، فرصة المشاركة العامة في التسيير والتدبير وفي الترقية الاجتماعية (في أفق تكوين الطبقة الوسطى). والثالثة، لأنه أسهم في تداول السُّلَط البلدية (الجماعية) والقروية (رغم أنه ترك السلطة الجوهرية المالية والسياسية الفعلية من خلال الوصاية الإدارية والمالية بيد وزارة الداخلية)، والرابعة، لأنه أسهم في ترسيخ الأحزاب ودورها (الدستور يعطيها هي والنقابات حق التنظيم والتأطير)، ولكنه بلور رؤية مختلفة ترمي إلى تحجيم دورها وكسر شوكتها. وقد ترافق ذلك مع التحولات الإيديولوجية لمعظم الأحزاب التقليدية التي كانت تسمّي نفسها بالوطنية والتقدمية ("التعادلية"، حزب الاستقلال، "الاشتراكية العلمية"، الاتحاد الاشتراكي، "الثورة الوطنية الديموقراطية"، حزب التقدم والاشتراكية) وهكذا.
قد لا تكون التعددية صورية، ولكنها غير ذات جدوى في علاقة بالاختيارات والحقوق والحريات
أما القضية الكبرى التي أسهم في ترسيخها، بوصفه تصوّراً أبوياً دينياً براغماتياً ذا طبيعة تدرّجية لتجاوز المطالبة بالديموقراطية وترسيخ الدولة الدينية، فيمكن تسميتها بـ"اللاوعي الجمعي"، بالمعنى الذي يفيد، في تحليلي هذا، أن جميع الحركات والهبات الاجتماعية تتأطّر، بخلاف التحولات العنيفة كالانقلابات والثورات القصيرة، أو طويلة الأمد، القائمة على استعمال العنف المسلح، بإطار يَحْكُم وَيَتَحَكَّم في جميع الممارسات السياسية وغير السياسية، وهو الذي أطْلِقُ عليه تعبير أو مفهوم (المجال الشرعي) الذي تأسّس في الحياة السياسية المغربية منذ أمد بعيد نسبياً، ولعله أخذ، في ظل ما سُمّي "العهد الجديد"، طابعاً خاصاً مميّزاً وثابتاً. وينفرد هذا "المجال الشرعي"، الذي هو أيضاً صنو الديموقراطية التحكمية، بوجود بنيتين تقومان على الفعل السلبي، وعلى ردّ الفعل الإيجابي، ولا يمكن هذا أن يكون سلبياً لأنّه محكوم بإكراه لا باتفاق (شريعة المتعاقدين). يمكن تسمية البنية الأولى بالفوقية الفاعلة، والثانية بالتحتية المنفعلة، وبينهما، بطبيعة الحال، تداخل وتجادل. ومن المفترض أن البنية الأولى تتألّف من ثلاثة عناصر، تختلف في درجة أهميتها وهيمنتها، أقصد: المُهَيْمِنُ، (يمارس السلطة يسيطر على باقي الآخرين، والأكثر أهمية هو الذي يفوز على الجميع)، الفاعلون، (أو الفاعل الذي مهنته أن يلعب دوراً فوق مسرح السياسة)، والتأثيرات (عملية ذات طابع متواصل تهدف إلى التأثير بفعل اتفاق، قانون، عرف). ولذلك تتألّف البنية الثانية من ثلاث نتائج يمكن اعتبارها بالمقوّمات التي تنبني عليها، وأعني بذلك: التحكّم أو التحكمية (طابع نظام سياسي، أو حكومة، يتميّزان بالتصرف الفردي، أو بتحكم بنية سياسية بطرق مختلفة...)، التوافق (سلوك وممارسة تقومان على التحكيم بين الطرفين، وتسوية تقوم على تنازلات متبادلة)، البيعة (الخضوع الطوعي، أو المفروض، أو التاريخي القائم على الوفاء، وعلى أشكال نفعية أخرى كالريع، الإكراميات، امتيازات إدارية ومالية وهبات).
ويمكن أن نُلاحظ في هذا "المجال الشرعي" مجموعة من العلامات ذات الأهمية القصوى تمثل ضوابطه وإسناداته. وأول ملاحظة بارزة يفيد مضمونها على مستوى التنظيم: أن عدد الأحزاب السياسية في المغرب قد بلغ، بحسب وضع الإيداع القانوني والترخيص الممنوح، 32 حزباً (مصدر: وزارة الداخلية). وثانيها من حيث النوع: وجود امرأتين على رأس حزبين: نبيلة منيب في (الاشتراكي الموحد) إلى حدود 2022، وزهور الشقافي عن (المجتمع الديموقراطي)، من بين تسعة أحزاب تُكَنّى بالديموقراطية يقودها رجال. أما ثالث الملاحظات من حيث الإكراه: فتعني أن "المجال الشرعي" ينبني، ضمنياً وصراحة أيضاً، على ما يمكن تسميتها "محدّدات التوافق"، والتي يسميها بعضهم بثوابت الأمة، وأذكر منها: الملكية وطبيعة النظام السياسي، الإسلام السني والمذهب المالكي، إمارة المؤمنين، الصحراء والوحدة الترابية، الليبرالية واقتصاد السوق، التقليدانية والاتباع، والولاء للتقاليد والعادات الموروثة، بما في ذلك الموقف من المرأة والجنس، وما ينصّ عليه القانون فيما يتعلق بالحريات الفردية، وحرية الاعتقاد. وأختم بملاحظات تالية: مفاد الرابعة يتعلق بمفهوم "الشرعية" في بعدين أساسيين: التاريخية (السُّلالة العلوية) والدينية (الشرافة، البيت النبوي)، إلى جانب بعد ثالث يمكن تسميته بالبعد الفعلي القائم على التسليم بالشرعيتين المذكورتين. ويؤول هذا البعد عادة على أنه الضامن للاستقرار ولأمن وحماية المواطنين من جميع التهديدات الفعلية أو المحتملة، كما يُقَارَن ضمنياً، وللتخويف كذلك، ببعض المآلات التي انتهى إليها ما سمي "الربيع العربي" في بعض البلدان، كسورية وليبيا.
المجال الشرعي يضمن الاستقرار السياسي، ولكنه لا يُحقّق السلم الاجتماعي بالضرورة
ويقوم هذا المفهوم على الاحترام الممكن، إن لم يكن التام، للدستور وللقوانين المعمول بها، هذا فضلاً عن الإكراه واحداً من مظاهر التحكم. والخامسة، تتعلّق بمفهوم التعددية، سياسياً ونقابياً ومدنياً، التي يصونها الدستور ويقرّها قانون الأحزاب، علماً بأنهما لا يعكسان، في الواقع، المضمون الفعلي للتعددية الماثل في التوجهات والاختيارات والتصورات المرتبطة بالنضال السياسي العام من أجل التغيير، أو في سبيل الإصلاح أو بغيرهما. وقد لا تكون التعددية صورية، ولكنها غير ذات جدوى في علاقة بالاختيارات والحقوق والحريات، لأنها قد لا تعكس بالمطلق طبيعة التعدد القائم في المجتمع والبلاد على الأصعدة الفكرية والإيديولوجية واللسانية وغيرها. أما السادسة والأخيرة فتخصّ مفهوم الدستور (2011) من ناحيتين شكليتين، على الأقل: باعتباره دستوراً ممنوحاً، رغم الحقيقة المعروفة من أن لجنة موسعة من الأطر والمهتمين والفقهاء الدستوريين والفاعلين السياسيين والحقوقيين والمدنيين ساهموا في إعداد الوثيقة واقتراح بنودها وبلورة موادها. أما الناحية الثانية فهي المتعلقة بقوانينه التنظيمية، تلك التي تسهل عملية تنزيله في الواقع باعتباره أسمى قانون والتي ما زالت معلّقة منذ صدوره في 2011.
والخلاصة العامة، بناء على هذا كله، أن "المجالَ الشرعي" محددٌ سلفاً، ويخضع للتوافقات (الإكراهات) التي تحدّ من انفتاحه وتلغي كل اختلاف فيه أو حوله، على الأقل في ما يرجع للتوافقات الكبرى التي يمكن أن نذكر منها: الملكية، وإمارة المؤمنين، والطابع الديني للدولة، والمذهب المالكي وما يوجبه من أقيسة أو يبرّره من معاملات إلخ، الصحراء، المفاهيم السائدة عن الأمن والاستقرار، مفهوم السوق (الحرية الاقتصادية)، ولا تدخل اللغة العربية في إطار ذلك رغم التنصيص عليها في الدستور. أضيف إلى هذا أن "المجال الشرعي" غالباً ما يرسم طبيعة المسار السياسي والتوجهات التي يمكن أن يسير على هديها بطريقة مضمونة، أو شبه مضمونة، باعتباره مصدراً لسلطة التوافق (الصوت الواحد) التي تقرّر في مختلف القضايا والأوضاع (التعبير عن الموقف من خصوم الوحدة الترابية، الموقف من الدين، الموقف من السيادة والدفاع عن حوزة الوطن).
"المجال الشرعي" محددٌ سلفاً، ويخضع للتوافقات (الإكراهات) التي تحدّ من انفتاحه وتُلغي كل اختلاف فيه أو حوله
والمفهوم أن المجال الشرعي يضمن الاستقرار السياسي، ولكنه لا يُحقّق السلم الاجتماعي بالضرورة، ولا يفلح في لجم الصراع الاجتماعي المبني على طبيعة المشكلات والقضايا التي تتبلور في ساحة النضال، بناء على الاحتياجات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية نفسها لمختلف فئات الشعب (تزايد معدلات الفقر، التهميش، التفاوت الطبقي...). وهذا ما يعني أنه يصادر بالقوة الفعلية، صراحة أو ضمناً، كل عمل ديموقراطي حقيقي، لأنه يعتبره تهديداً واضحاً للتوافق المتحكّم فيه، مثلما يهدف إلى طمس التعارضات، وتجريم الاختلاف، وتحقير الأقليات، وكبح جماح مختلف المعارضات الممكنة، أو تطويعها، وحبك الدسائس والمؤامرات لتشويه أهدافها عندما يظهر على خطابها، أو ممارساتها، مواقف قد تنزع إلى ما يؤول عادة بأنه خروج عن "الشرعية". وأضيف إلى هذا أنه، في مجالات مخصوصة، يَحُدّ من جميع الحريات "المضمونة" بالدستور، وبعضها بالقانون، وذلك بمقياس، أي بطريقة نفعية تستجيب لاختيارات السلطة ولظروفها وتصرّفاتها، وهذا كله في تعارض تام مع التصريح بشعارات كالديموقراطية (وما في معناها كالعمل الديموقراطي، الحياة الديموقراطية إلخ)، والحرية ودولة المؤسسات وسواها، للأهمية المُتَصَوَّرة، من الناحية الشكلية، في الإقناع بفكرة (الانسجام، التوافق، التسليم بالكونية) مع القواعد المقررة، والتبعات الجزائية Criminal Consequence المتضمنة فيها، في القانون الدولي، أو في المنظمات والهيئات القانونية والحقوقية، أو تلك الساعية إلى إقرار الحكامة الرشيدة. ويمكن القول إن الغائب الأكبر في "المجال الشرعي" هو الديموقراطية الحقيقية، كنظام للحكم المعروفةِ أسسه وضوابطه والخصوصيات التي يمكن أن تقترن به في ما يرجع منها لضوابطها الأساسية: فصل السلط، والحريات العامة وضمان حق الأقلية والتوزيع العادل للثروة الوطنية إلخ.
وخلاصتي الجوهرية هي أن "المجال الشرعي"، لما سبق ذكره، لا يصوغ الإرادة الشعبية في علاقة بالديموقراطية وما قد يرتبط بهذه الديموقراطية من أسس، بل يكرّس الولاء من خلال التحكّم على المستوى الشعبي وعلى صعيد النخب، وله تجليات أخرى على الصعيد الاقتصادي الصرف، ومنه الارتباط العضوي بين الرأسمال والسلطة، وانتفاء المحاسبة في علاقة بالمسؤولية، ترسيخ بنية الفساد المعيقة لتطور الدولة وإحباط التنمية وتقويض أسباب النهوض الاجتماعي بعامة.


.png) 6 days ago
4
6 days ago
4





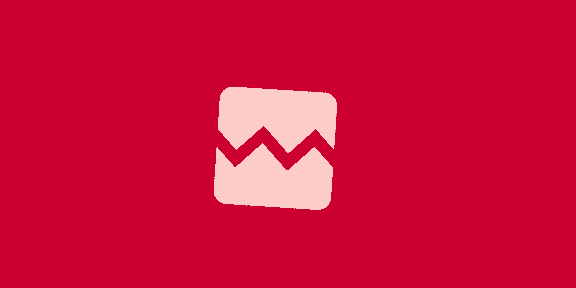



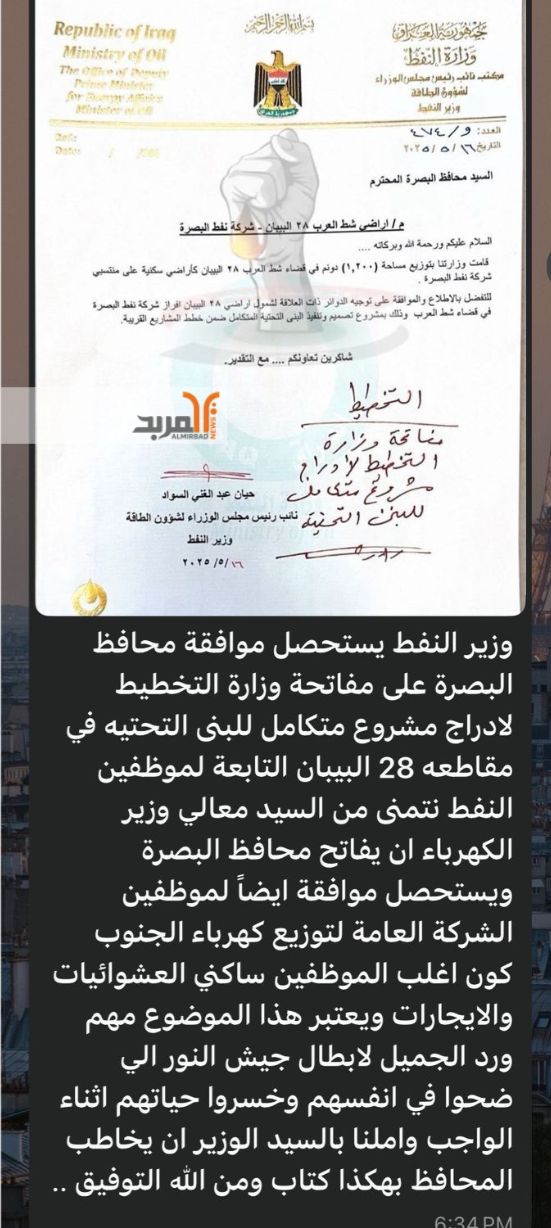
 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·