ARTICLE AD BOX
تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، في 8 مايو/ أيار الحالي، مشاهدَ عشرات الطلاب الدروز السوريين يغادرون مبنى السكن الجامعي في دمشق عائدين إلى محافظة السويداء، ويناقض هذا المشهد، بألمه ووجعه، مشهداً ملؤه البهجة، يعود تاريخه إلى 29 سبتمبر/ أيلول 1918، ويُظهر سلطان باشا الأطرش رافعاً العلم العربي في دمشق، ممهّداً لحكومة عربية جامعة لأطياف بلاد الشام كافّة، وفسيفسائها المتعدّدة والمتنوّعة. لم يكن ذلك الأمل المكسور بعد سنتين (معركة ميسلون) سوى تعبير عن أفق سياسي وفكري حالم وواسع، نشده القوميون العرب الأوائل، متجاوزين وعورة (وتضاريس) الواقع الاجتماعي لأهالي الشام، فصاغوا دستوراً عام 1919، لا يمكن وصفه إلا بأنه خريطة رجاء نحو الانتقال إلى مواطنية عربية بدت مقبولةً ومستساغةً عند أهل الحلّ والربط، وعند الجمهور العام أيضاً.
بعد أكثر من مائة عام على خيبة الأمل وانكسار الرجاء، تبدو التعدّديات الاجتماعية الشامية أقرب إلى أن تحمل كلّ واحدة منها في بطونها "قومية مخفيّة"، إذا جاز اقتباس الفكرة التي يتحدّث عنها محمد علي مكّي في واحدٍ من أهم الكتب التي عالجت التاريخ اللبناني الحديث (والشامي ضمناً وحُكماً) وصدر عن دار النهار البيروتية عام 1977، بعنوان "لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني". لكن تلك "القوميات المخفيّة" كاد التذويب يخفيها، أو يخفض وتيرتها، في إطار القومية العربية النهضوية، أو في أطر الجامعة الوطنية التي عرفتها الدول القُطرية في مراحل نشوئها الأولى، وما أعقبها من دورات سياسية في أطوارها التالية، التي لم يُكتب لها العمر المديد، فانقلبت مرحلةُ ما بعد الاستقلالات انتكاساتٍ أطلّت معها "القوميات المخفيّة" برؤوسها من جديد تعبيراً نابذاً لـ"العروبة المُستبدَّة" أو الحزبية التي أنعشت أرواح الطائفيّات والعشائريات، كما يقول المفكّر السوري ياسين الحافظ في "الهزيمة والأيديولوجيا المهزومة" (1978). وفي ذاك الكتاب، ما ينطوي على استشرافٍ مبكّر لمسالك وأساليب الممارسة السياسية التي اعتمدتها "العروبيات الحزبية"، فأعادت إنتاج الهُويَّات الاجتماعية الضيّقة، ومن حيث تدري أو لا تدري، فقد قصمت تلك العروبيات ظهر العروبة الجامعة.
ربّما تفوت الذاكرة السياسية أدوار فائقة التأثير، أدّاها الموحّدون الدروز في نشوء أو تنمية أو صياغة أقطار عربية عدّة، ومن منطلقات لا تتّصل إلا بالرابطة العربية أو الوطنية، وفي واقع الحال، امتدّ ذلك التأثير، وذاك الدور، من سورية إلى الأردن إلى السعودية، هذ إذا جرى استثناء لبنان الحديث من أنه امتداد كياني، بشكل أو بآخر، لـ"إمارة الدروز"، التي توطّدت مع الأمير فخر الدين الثاني في الثلث الأول من القرن السابع عشر للميلاد.
يحفظ الأردنيون أدوار الموحّدين الدروز في بناء مؤسّسات دولتهم، وما فتئت الصحف الأردنية تستعيد تلك الأدوار بين آونة وأخرى
بما يخصّ سورية، يتقدّم سلطان باشا الأطرش بمشاركته الطليعية في ثورة العرب الكُبرى عام 1916، ومن ثمّ إطلاقه الثورة الوطنية السورية عام 1925 من جبل الدروز في سورية. ومن الجبل أصدر بيانه الشهير قائداً عامّاً للثورة السورية، ودعا فيه إلى "وحدة البلاد السورية، ساحلها وداخلها، والاعتراف بدولة سورية عربية واحدة مستقلّة استقلالاً تامّاً، وقيام حكومة شعبية".
وفي سلسلة الأدوار الدرزية في سورية، يبرز اسم عادل أرسلان، ومن مناصبه رئاسة أمانة السرّ في مرحلة المملكة السورية الهاشمية، ثمّ تولّى وزارات الخارجية والدفاع والتربية في السنوات الأولى بعد استقلال سورية، فيما جهد فريد زين الدين، ناصري الهوى والميل، في إقناع الرئيس السوري شكري القوّتلي بإعلان الوحدة مع مصر عام 1958، وإذ أشرف على المديرية العامة لوزارة الخارجية السورية، فقد عُهدت إليه نيابة وزير الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة، وساهم في صياغة ميثاق الأمم المتحدة. ويندرج في هذه السلسلة الفريق عبد الكريم زهر الدين، الذي شارك في حرب فلسطين 1948، وعُيّن قائداً للجيش السوري سنة 1961، ووزيراً للدفاع بعد سنة من ذلك، ولم يُعرَف عنه تأييده العمليات الانقلابية التي طبعت عقوداً من التاريخ السوري المعاصر، وترأّس عارف النكدي (1887 ـ 1974) مجلس الشورى السوري، ثمّ تولّى قيادة الشرطة في عهد الرئيس القوتلي، في حين كان شبلي العيسمي واحداً من كبار قادة العمل السياسي والفكري في سورية، وحمل عدّة حقائب وزارية في عقد الستينيّات الماضي.
في الأردن، يحضر مرة ثانية عادل أرسلان رئيساً للديوان الأميري بين 1921 و1923، ومعه رشيد طليع رئيس أولى الحكومات الأردنية عام 1921، وفؤاد سليم، أوّل قائد للجيش الأردني، وقد استشهد في مواجهة مع القوات الفرنسية عام 1925 خلال الثورة الوطنية السورية. وعموماً، يحفظ الأردنيون أدوار الموحّدين الدروز في بناء مؤسّسات دولتهم، وما فتئت الصحف الأردنية تستعيد تلك الأدوار بين آونة وأخرى، وفي نصوص المؤرّخين الأردنيين ما يفيض بالحديث عن الأدوار المذكورة، ومن ضمنهم علي محافظة في كتابه "تاريخ الأردن المعاصر... عهد الإمارة" (1973).
ولا يُخفي السعوديون أيضاً دور فؤاد حمزة، كبير مستشاري الملك عبد العزيز آل سعود ومدير عام وزارة الخارجية، إذ "شارك في رسم سياسة المملكة نحو ربع القرن"، على ما كتبت صحيفة الرياض (22/9/2017)، وتصدّر رأس قائمة الباحثين في التاريخ السعودي، ومن مؤلّفاته "قلب جزيرة العرب" و"البلاد العربية السعودية" و"في بلاد عسير". وفي جانب آخر، يروي قائد جيش الإنقاذ فوزي قاوقجي، في مذكّراته، أن المفكّر القومي العربي الدرزي شكيب أرسلان، ومن طريق فؤاد حمزة، مهّد له الوصول إلى الملك عبد العزيز، ليُصار بعد حين تكليفه بتنظيم الجيش السعودي.
تفوت الذاكرة السياسية أدوار فائقة التأثير، أدّاها الموحّدون الدروز في نشوء أو تنمية أو صياغة أقطار عربية عدّة
وحيال فلسطين، يأتي في طليعة العاملين في سبيلها المفكّر علي ناصر الدين (1888 ـ 1974)، الذي انخرط شابّاً في الثورة العربية الكبرى، ثمّ سعى مع رفاق له إلى تأسيس عصبة العمل القومي عام 1933، لتكون الممهّد العقائدي للمنظومة الفكرية لحزب البعث، واستطراداً لحركة القوميين العرب، اعتماداً على كتابه "قضية العرب". وناصر الدين المولود في لبنان كان مشاركاً في صوغ السياسات العامّة لصحيفتَي الكرمل والجمعية الإسلامية الفلسطينيّتين، وطرَده الإنكليز من فلسطين، واعتقله الفرنسيون مرّة تلو أخرى من جراء فكره القومي، وكانوا يغلقون الصحف التي يصدرها، كما هي الحال مع صحيفتَيّه المنبر واللواء.
أمّا عجاج نويهض، فكان من روّاد الصحافة والسياسة في أثناء الحكم الهاشمي في دمشق، وبعد سقوط الحُكم المذكور عام 1920، غدا مقرّباً من المفتي العام للقدس الحاج أمين الحسيني، وبات مديراً لمكتب المجلس الإسلامي الأعلى، ومساعداً للمفتّش العام للمحاكم الشرعية الفلسطينية، وهو من الشخصيات المؤسّسة حزبَ الإستقلال العربي في فلسطين المناهض للإحتلال والاستيطان عام 1932. وفي القدس، أصدر مجّلة العرب، وأدار الإذاعة العربية، وبعد ذلك، أشرف على دائرة النشر والمطبوعات في الأردن.
ومن الأسماء الدرزية المرموقة، هاني أبو مصلح (1893 ـ 1971)، الذي كان يُلقي الخُطب في مساجد حيفا محرّضاً على مواجهة مشاريع الاستيطان والسياسات الإنكليزية، وكان بدأ مسيرته السياسية صحافياً مُفلحاً ومُجلياً إبّان فترة الحكم الفيصلي في دمشق، ثمّ انتقل إلى العمل في صحيفة الصباح المقدسية التي كان يصدرها الرائد في الصحافة الفلسطينية كامل البديري الذي اغتيل عام 1923، وبعد امتهانه التدريس في شفا عمرو، عانى وطأة الاعتقال الإنكليزي وعتمة السجن مراراً.
يبقى ختام القول سؤال: هل تُقرأ مسيرةُ الموحّدين الدروز خلال قرن بعين وطنية؟ وطنية تجمع ولا تقطع وتجذب ولا تنبذ؟


.png) 1 week ago
6
1 week ago
6


/AFP__20250523__47XL4JL__v2__Preview__FblItaSerieANapoliCagliari.jpg)







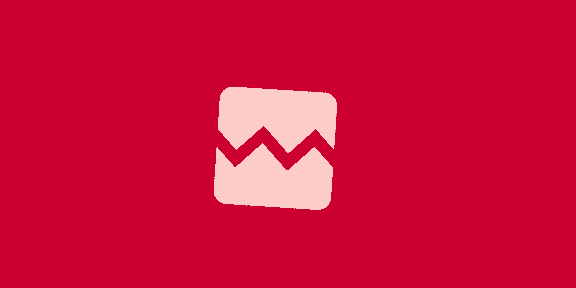
 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·