ARTICLE AD BOX
لا يمكن تجريد السياسة من الفلسفة، فالسياسة من بين الفضاءات التي لا يمكن فهم ما يعتمل داخلها من تحوّلات وسجالات وصراعات وتناقضات، بعيداً عن المنظور الفلسفي، خاصةً أنّ السياسة، مثل غيرها من الحقول، علم، ولا يمكن لنا أن نفهم أيّ علم بدون رؤية فلسفية، ونستذكر هنا ما قاله، مرّةً، أستاذ الفلسفة المغربي عزيز حدادي "الفلسفة تأتي في الصباح، فيما العلم يأتي في المساء"، الفلسفة أولاً والعلم ثانياً. الفلسفة سابقةٌ على العلم، لا تقليلاً من أهمية هذا الأخير، وإنما تأكيد أنّ العلم الذي "أتى في المساء"، اشتغل بالأسئلة التي أثارتها الفلسفة قبل ذلك، حتى قبل فلاسفة الإغريق القدامى الأكثر شهرة في تاريخ الفلسفة، ونعني بهم فلاسفة الأمم الشرقيّة في الصين والهند مثلاً. واستطراداً، في وسعنا القول بما أنّ السياسة علم وإن جمعت بينه والممارسة، فإنّها تأتي بعد الفلسفة، أو للدقّة بعد ما أثارته من أسئلة.
من القامات الفكرية والفلسفية التي قاربت فلسفة السياسة حنه آرندت التي كانت ممن دعوا إلى إنزال الفلسفة إلى الواقع، فلا تكون مجرّد تهويمات ميتافيزيقية، منفصلة عن انشغالات المجتمع أو متعالية عليها. ودعوةٌ مثل هذه تجعل من فلسفة السياسة ليس مجرد تنظير مجرّد، إنّما هي معاينة لواقعٍ متحرّك، إن على مستوى كلّ مجتمع وحده أو كلّ قارة وحدها، وحتى على المستوى الكوني، ولكي نقف على التحوّلات المصيريّة التي شهدها العالم وغيّرت مساراته، لا بد من الوقوف على الرؤى الفكريّة والأيديولوجيات التي كانت بمثابة روافع، أو دوافع، لتلك المنعطفات. يصحّ هذا على نظرياتٍ مختلفة حدّ التناقض، كالماركسيّة والحركات القوميّة والدينيّة على أنواعها، سواء كانت في مواقع المعارضة أو حين تصبح محتكرة للعنف عندما تمسك بمفاصل السلطة.
وفي هذا السياق، الزعم بإمكانية النظر إلى السياسة بمعزل عن التأطير النظري – الفلسفي لا يصمُد أمام الحجاج، كما لا يصمُد أمام الحجاج الزعم أنّ في وسع المشتغل بالفلسفة أو الفكر أن يكون محايداً أو غير منحازٍ إلى موقف، هو في جوهره موقف أخلاقي – سياسي مركّب، بالمعنيين الإيجابي أو السلبي، تبعاً للحال التي نحن بصددها، شخصاً وموقفاً، وحتى القول باللا أيديولوجيا، هو في الجوهر موقف أيديولوجي، حتى لو لم يطق دعاة ذلك أن يُطلق عليهم وصف "المؤدلجين"، فلا يمكن مقاربة موضوعات مثل الهُويّات، والثروة، والاقتصاد السياسي، والبيئة والجنوسة وقضايا المرأة، وما إليها من موضوعات حيويّة تشغل العالم بدون حمولة أيديولوجية ما، سواء اتفقنا معها أو اختلفنا.
وحتى لو جرى النظر إلى السياسة بوصفها صراعاً على المصالح والنفوذ، فهذا الصراع يلزمه نوعٌ مما نود وصفه بـ"الإسمنت الأيدولوجي"، الذي هو، في أحد جوانبه، على الأقل، ضرب من الفلسفة، من أجل أن يبرر فيه كل طرف غاياته من خوض هذا الصراع، وإضفاء طابع قيميّ – أخلاقيّ عليها، وفحص وتحليل مدى صدقيّة ذلك، ومقدار الحقيقة أو الزيف فيه هي مهمة فلسفية بامتياز، حتى لو بدا في الظاهر أنها تتناول أمراً محض سياسي، فلا يمكن مقارنة خطاب شعبٍ احتلت أرضه واغتصبت حقوقه وصودرت السيادة الوطنية لبلاده، بخطاب المستعمر والمحتل والمغتصب، حتى لو أسبغ على هذا الخطاب مسحة من الأخلاق والقيم، كالزعم أن الغاية من هذا الاستعمار أو الاحتلال نقل شعب أو بلد متخلف إلى ضفّة الحضارة والديمقراطيّة، كما تفعل الدعاية الغربية في تبريرها العدوان الصهيوني على حقوق الشعب الفلسطيني، أو كما برّرت الولايات المتحدة احتلالها للعراق، الذي أعاد البلاد عقوداً إلى الوراء، ودمّر الدولة الوطنيّة التي بنيت بجهود سواعد أجيال من العراقيين وأدمغتهم.
في كتاب "نزهة فلسفية في غابة الأدب" الذي ترجمته لطفيّة الدليمي، وهو حوارية بثّها التلفزيون البريطاني بين آيريس مردوخ وبريان ماغي، والاثنان من بريطانيا نفسها، عن العلاقة بين الأدب والفلسفة، كون الأولى تجمع بينهما فهي روائية وفيلسوفة في الآن ذاته، فيما الثاني أيضاً فيلسوف وكاتب، يقول ماغي "لا تقوم الفلسفة إلّا بشيء واحد"، وفي تقديرنا أنّ هذا الشيء وإن كان واحداً فقط، فإنّه ينطبق عليه قولُ وزير الخارجية الأميركية الأسبق هنري كيسنجر إنّه درس الفلسفة لا حبّاً في أفلاطون أو أرسطو أو سواهما، وإنما لأنّ "الفلسفة لا تترك خليةً واحدة في الدماغ عاطلة عن العمل".


.png) 6 days ago
4
6 days ago
4









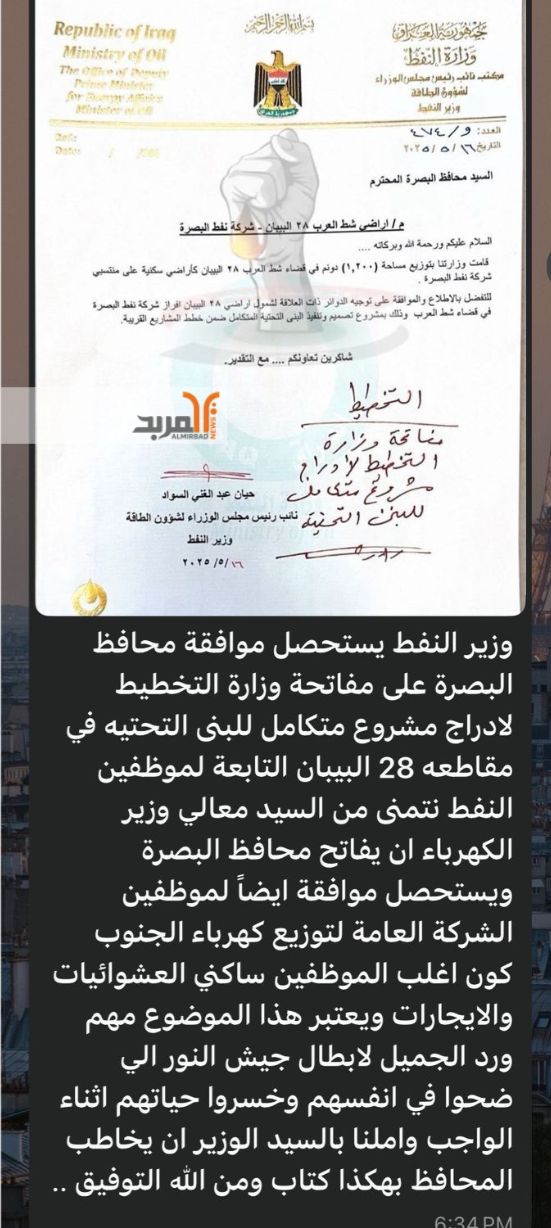
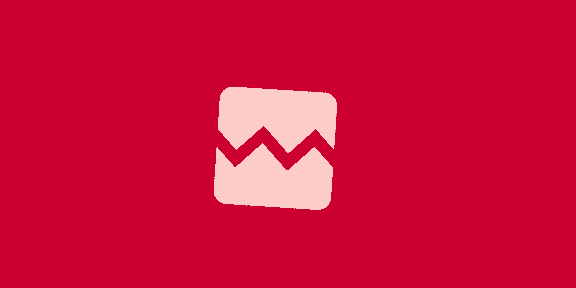
 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·