ARTICLE AD BOX
رغم تباين أزمات السودان وسورية ولبنان واليمن والعراق، رأسياً وأفقياً، تبدو استنساخاً لقضية قُطرية واحدة. كلّها تنبت وتنمو داخل فراغ ناجمٍ من غياب مشروعٍ وطني. هذا الفراغ، ثمّ الغياب، وراءهما صراع النُّخب من أجل السلطة بأدوات غير ديمقراطية، بل بأسلحة غير سياسية. غلّب هذا الصراع ثقافةً ذرائعيةً جذّرت استبداداً لم يقتصر على السياسة، بل طاول الفكر والتنظيم والتعبير والدين. تضافرت هذه العناصر كلّها لتفريخ الفساد، ثمّ استشرائه. لهذا عجزت موجاتُ الانفجارات في تلك الأقطار عن اختراق طبقات الأزمات المتراكمة. يتجسّد مكمن الأزمة في عجز النُّخب عن صوغ مشروع وطني مبني على ركائز إنسانية، سياسية وأخلاقية، من شأنه انتشال شعوب هذا البلدان من حالات التدهور الاجتماعي والتسكّع الاقتصادي والتفتّت الديمغرافي والتجزئة السياسية.
يكتسب الوعي الجوهري حيويةً في أجواء الانفتاح، فيكرّس الحوار أداةً لإدارة القضايا الوطنية
ربّما لو نعمت الشعوبُ بتجاربها الديمقراطية المبكّرة مطوّلاً، لنجحت في تطوير آلياتها السياسية، وصولاً إلى مشاريع وطنية. تلك غاية رهينة بخوض الصراع بأدوات سياسية وأسلحة ديمقراطية، لكنّ النُّخب المتعطّشة للسلطة لجأت إلى الاستعانة بالعسكر من أجل بلوغ غاياتها، ضاربةً بذلك الوازع الوطني (الضابط الاجتماعي) فأصبح العدوان على الأفراد والمجتمع ممارسةً مألوفةً، بل مقنّنةً. شهوة السلطة أعمت الانقلابيين عن إدراك أن ذلك هو بداية الانهيار على مستوى المجتمع والدولة. في ذلك العمى يتساوى أهل اليسار من القوميين والاشتراكيين، واليمين من الإسلاميين و"الرجعيين". سقطت كلّها بعد استيلائها على السلطة في اختبار الإدارة الوطنية بشفافيتها ونزاهتها. على نقيض ذلك، تورّطت في الفساد والاحتكار والإقصاء والقمع والإخصاء. القاسم المشترك بين تلك التيّارات يتمثّل في تكريه الشعوب للقالب الغربي للديمقراطية.
رغم البؤس الوطيد، لم تتعلّم النُّخبُ عدمَ ارتهان الإنجاز الوطني للسلطة والثروة وامتيازاتهما. كما لم تدرك أن الفساد لا يجلب الخير والتقدّم، وأن الفضيلة تُراكم رصيداً أوسع وأبقى على الصعيد الوطني. لكن إشكالية النُُّخب (المُركّبة) تتركزُ في عدم الوعي بأن النجاح الأكثر جدوى، ليس في التشبّث بالتراث الموروث من الآباء، بقدر ما هو في الإرث الممكن إنجازُه بأيدي الأبناء والأحفاد، كما أن التاريخ يتحدّث بكلّ اللغات أن ليس من طبع السلطة والثروة الثبات، وكذلك امتيازاتهما، بينما المساهمة في صناعة التاريخ بدوافع الخير والتقدم أرسخ بقاءً. ذلك الوعي الجوهري ينبع من الاعتراف في المقام الأول بالفوارق في الأسئلة الحياتية، ثمّ الإجابات عنها في كلّ بلدٍ وأمام كلّ شعبٍ عبر الأزمنة المتباينة. هذا الوعي هو المحرّك الأساس لحركة التاريخ، فمن دون امتلاك ناصيته تصبح الصفوة، وما تملك من معرفةٍ، مجرّد رأسمالٍ معطَّل. فالمعرفة رغم أهميتها تفقد قيمتها خارج قنوات الحوار.
يكتسب الوعي الجوهري حيويةً في أجواء الانفتاح، فيكرّس الحوار أداةً لإدارة القضايا الوطنية، فالحوار وحده يتيح فرص إثراء المعرفة، ومن ثمّ الوعي. لكن الأهمّ من ذلك إفساح متّسع أمام البنّائين النشطين لاستنهاض الرأي العام واستنفار الجماهير داخل أُطر اجتماعية وسياسية في درب الخير والجمال والتقدّم، فالعمل الجماهيري غير المنظّم يتّخذ طابعَ الفوران المؤقّت أو يتمظهر في أشكال من الفوضى غير الخلّاقة. وحدَها التنظيمات المحكمة بالوعي والانضباط في التخطيط تمنح عمليات التغيير وحركة التقدّم الفعاليةَ والكفاءة، فعبر هذه المواعين يمكن فقط ترتيب الأجندة الوطنية على المستويات المتعدّدة. فإذا كانت السياسة الناجعة في أبسط تعريفها تحديد الأهداف، فإن الاستراتيجية ليست سوى ترتيب تنفيذ تلك الغايات.
في ظلّ التكالب على امتيازات السلطة عجزت النُّخب العربية عن تحقيق أيّ إنجاز على الأصعدة كلّها
هناك فارق فاقع بين التنظيمات السياسية المبنية من القواعد بواسطة بنّائين وتنظيمات فوقية مصنّعة من السلطات. توفير الحرّيات أمام الجماهير لبناء منظّماتها يؤمّن بلوغ الانتصارات الحقيقية، لكن التنظيمات المتنفّذة في نُخب السلطة تتحوّل إلى أجهزة قمعٍ تصادر حرّيةَ التعبير والتنظيم، إذ تجرّم الصوت المعارض. ذلك يعني، في أبسط تعريفاته، تكريسَ الهيمنة مقابل تغييب الشفافية في ظلّ تجريم العمل المعارض. أخطر ما في هذا النهج الشمولي تحويل الطبقة الوسطى من قاطرة لقيادة التغيير إلى ماكينة تفرز آليات التسلّط والفساد والخيبات، بدلاً من التحالفات السياسية القائمة على تجانس الرؤى، أو على الأقلّ تقارب المواقف، تبرز صفقات المصالح وعلاقات الزبائنية. المواطن هو من يسدّد فواتير تلك العلاقات، وبكلفة باهظة، تنداح على أجل لاسقف له. لذلك لا تعايش الشعوب آلام الخروج من العصر فقط، بل هي تواجه أخطار الخروج من التاريخ والجغرافيا.
في ظلّ التكالب على امتيازات السلطة، عجزت النُّخب العربية عن تحقيق أيّ إنجاز على الأصعدة كلّها. بادرت الصفوة الفرنسية بإضاءة عتمة الاستبداد في وقت مبكّر. الإنكليزية رسّخت مفاهيم الحرّيات السياسية والاقتصادية. الروسية ذهبت في درب الاشتراكية. الألمانية حقّقت اختراقاً في الميكنة. اليابانيون نفّذوا قالباً مثيراً للنهوض من تحت الرماد. الصينيون أرسوا مداميك الثورة بأبعادها المتباينة. في ماليزيا وكوريا وإندونيسيا وسنغافورة والهند، تجاوزت النُّخب العراك المُعطِّل على السلطة، فأنتجت اختراقات مذهلة في ميادين الحياة.


.png) 5 hours ago
1
5 hours ago
1





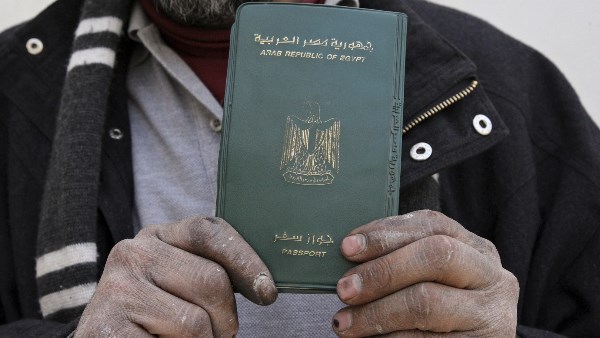





 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·