ARTICLE AD BOX

<p>أصوات عدة تطالب أو تجتهد لإصلاح "الذوق العام" بين وقت وآخر، لكن غالبية هذه المطالبات لا تسفر عن إصلاحات (أ ف ب)</p>
الجميع اتفق على أن الذوق العام يعاني الأمرين. الفن في محنة، وسلوكيات الشارع تواجه معضلة، وقواعد الذوق ضربتها الأنيميا، ومنظومة الجمال والهندام ليست في أفضل حالاتها. صحيح أن الجميع يختلفون في ما بينهم حول الأسباب، ومن الاختلاف ما يتحول إلى تراشق بالاتهامات حول المتسبب في مشكلة الذوق العام، لكن الاتفاق يبقى سيد الموقف.
تأريخ المرض يعود إلى السبعينيات. المعايير والقيم الاجتماعية والثقافية التي توجه الذوق العام للجماهير الغفيرة بدأت تتغير بصورة لافتة ومتسارعة في سبعينيات القرن الماضي، وهو التغير الذي اتضح بشدة في بداية موجة أفلام سميت بـ"أفلام المقاولات"، وإن لم تقتصر عليها.
"أفلام المقاولات" لخصت الأزمة وأصبحت رمزاً لها، وبمرور العقود لم تعد أزمة بل واقع حال جديدة تتواءم معها الجموع، وينبري مثقفون ومعهم قلة متمسكة أو متذكرة أو مستحضرة معايير ذوق عام أفضل وأرقى، ليطالبوا بنظرة أو تدخل أو احتراز أو إنقاذ لما تبقى، وذلك بين الحين والآخر كرد فعل موسمي على عمل أو حدث أو حادثة تسلط الضوء على تردي الذوق العام.
في رمضان الماضي عادت جدلية الذوق العام لتصبح قضية القضايا وحديث الساعة وأم المعارك. نقطة الانطلاق هذه المرة كانت دراما رمضان، أصوات عدة تعالت معترضة على ميل الكفة بصورة فجة نحو تدني الذوق العام، ومنها ما عالج التدني بمزيد من التدني، والمحصلة النهائية كانت شعوراً عاماً لدى النخبة بأن دراما رمضان عكست مدى تدني الذوق العام من جهة، ومن جهة أخرى أسهمت في انتشار أو تجذير أو تعظيم هذا التدني عبر تجسيده والتركيز عليه وتقديمه باعتباره الواقع الجديد.
من الشاشة إلى الشارع
تصاعد الجدل حول الذوق العام انتقل من الدراما إلى تفاصيل السلوكيات في الحياة اليومية، توسعت دائرة النقاش بين من يرى أن المتهم هو الدراما لأنها تروج للتدني وتفتئت على الإثارة، ومن يؤكد أن التدني في الشارع قبل الدراما، وأن المتهم هو من ترك هذا التدني في الذوق العام يتنشر ويتوسع ويتحكم. أما الدولة فقررت أن تشمر عن ساعديها لتعيد ترسيخ الضوابط المجتمعية، لا سيما بعد ما قال الرئيس السيسي "أنا خائف على الذوق العام".
الرئيس تحدث في احتفالية المرأة المصرية في مارس (آذار) الماضي عن الدراما المصرية، وكيف أنها كانت في الماضي صناعة ذات أهداف واضحة، حين كانت الدولة تسهم في الإنتاج التلفزيوني بصورة مدروسة، وتعتمد على رؤية علمية يضعها متخصصون في الإعلام وعلمي النفس والاجتماع، وهو ما كان يؤثر إيجاباً في المجتمع ويسهم في صياغته ثقافياً وفكرياً. وقال إن العقود الأربعة الماضية شهدت تحولات كبيرة، وزادت الأعباء على التلفزيون الحكومي، مما جعله غير قادر على أداء الدور الذي كان يقوم به في السابق، فتحولت الدراما من صناعة ذات أهداف ثقافية إلى تجارة تهدف إلى الربح، مشيراً إلى أن تحقيق الأرباح يجب ألا يكون على حساب جودة المحتوى، وأن ما يعرض على الشاشة له تأثير بالغ في تشكيل وعي الأفراد وسلوكهم.
وعلى رغم أن الرئيس السيسي لم يقصر حديثه على الذوق العام، أو يحصر خوفه عليه في سياق الدراما فحسب، بل تحدث عن أدوار يلعبها الإعلام والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة والأسرة، وجميعها يشكل وعي المجتمع، فإن شعوراً شعبياً وحكومياً سرى بأن الدراما هي المتهم الرئيس المسؤول عن انفلات الضوابط المجتمعية وتدني الذوق العام.
هرولة واجتماعات
وعليه، شهدت الأسابيع الماضية هرولة لعقد اجتماعات للبحث في كيفية الارتقاء بالذوق العام، وتركيز لتنظيم لقاءات لرسم خطط ووضع تصورات لإعادة تنظيم الضوابط المجتمعية، واهتمام بتشكيل مجموعات عمل للبحث في سبل تعزيز الرسائل الإيجابية، وهيكلة لجان لتعزيز القيم الثقافية وإعادة ضبط الموازين الاجتماعية، وجميعها ينصب على الدراما.
وبين مجموعة عمل متخصصة لصياغة رؤية تعزيز الرسائل الإيجابية للإعلام والمسرح تجاه المجتمع، ولقاءات تجمع مسؤولين من وزارة الثقافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركات إنتاج وكتاب ومثقفين وخبراء ونقاد، تتسارع الخطوات لضبط الذوق العام.
الغالبية تتعامل مع تلك الخطوات التي تتبناها الدولة بارتياح، فقد حان وقت تصحيح المعايير الملتوية وضبط الأوضاع المعوجة وتنقيح الأخلاق وتطهير السلوكيات، وجميعها أصابه ما أصابه من تدنٍّ وتدهور وتقهقر بسبب المحتوى الدرامي مضافاً إليه توليفة من الأغاني الهابطة والسوقية.
الأقلية وجدت نفسها في حيرة من أمرها لأسباب عدة، معظمها أسئلة لا تجد إجابات منطقية، هل يمكن ضبط الذوق العام؟ وكيف يمكن ضبطه؟ وهل عملية الضبط تتبلور بقرارات ولجان وتوصيات؟ وحتى لو سُنت قوانين ولوائح، هل يرتدع الذوق العام ويضبط نفسه ويصحح ذاته خوفاً من الحساب والعقاب؟ وهل الضوابط المجتمعية قابلة للإصلاح؟ ومن يصلحها؟ وكيف؟ وهل هناك أمثلة من التاريخ القديم أو المعاصر يمكن الاقتداء بها والنقل عنها تمت في هذا الشأن بهذه الصورة؟ وهل فسد الذوق العام وانحلت عقد الضوابط المجتمعية بسبب الدراما وحدها؟ وما الذوق العام؟ وما المعايير المجتمعية؟ وهل مهمة الدولة ومسؤوليها ضبط الذوق العام وإصلاح الضوابط المجتمعية؟ وفي حال كانت هذه مهمتها ومهمتهم بالفعل، هل هي وهم قادرون على ذلك؟ وهل الإصلاح يكون عبر تشكيل اللجان والخروج بتوصيات وتطبيق لوائح؟
أسئلة الأقلية
هذه الأقلية وهذه الأسئلة غالباً تجد نفسها متهمة من قبل الغالبية إما بالمعارضة لغرض المعارضة، أو التشكيك بغية التشكيك أو قصر الفهم، ويصل الأمر أحياناً إلى اعتبارها قلة سعيدة بتدني الذوق العام ومنتفعة من انفلات الضوابط المجتمعية.
وبين مخاوف الأقلية من تدخل الدولة في الفن وبسط قبضة الرقابة على الثقافة والإبداع، وترحيب الغالبية – بما فيها الجماهير العريضة التي تشكل القاعدة العريضة أيضاً من مشاهدة الأعمال المتهمة بالتسبب في تدني الذوق العام وتدهور الضوابط المجتمعية في مفارقة عجيبة - بهذه الخطوات، يجتهد آخرون للبحث في ماهية الذوق العام والضوابط المجتمعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والملاحظ أن شعوراً أو انطباعاً أو إيماناً أو رغبة مجتمعية عارمة تحصر كلاً من الذوق العام والضوابط المجتمعية في ثالوث قوامه: المرأة والبلطجة والبعد من الدين. الطريف أنه لا يوجد تعريف محدد أو إجماع معروف لكلا المفهومين، لا في القانون أو في الكتب أو حتى العرف والتقاليد. والأكثر طرافة أن كثيراً من دول العالم وشعوبه، ومنها ما هو مصنف ضمن الأكثر تقدماً، لا يشغله الذوق العام أو تقلق منامه الضوابط المجتمعية، لا لتدني هذا أو انفلات ذاك، ولكن لأن التعليم يبني والتنشئة ترسخ والقانون يضبط، وكل ما عدا ذلك يندرج تحت بند الاختيارات الحرة ما دامت لم تخرق القوانين.
حتى عبارة "الذوق العام" Public taste إما لا وجود لها في دول وثقافات عدة، أو أنها تستخدم لتعني "المذاق العام" لا سيما في ما يختص بالأطعمة ونشر مفاهيم غذائية والعمل على تنمية شعبية مكونات بعينها مثل الخضراوات والفاكهة، أو تقديم مكونات جديدة مثل "الماتشا" و"الكامبوتشا"، وربما التطرق إلى الجوانب الربحية من توجيه المذاق العام في اتجاهات بعينها. وفي أضيق الحدود يُشار إلى "الذوق العام" في ما يختص بالموسيقى والفنون والموضات ومعايير الجمال السائدة.
وهناك عدد محدود من الدراسات والكتب عن "الذوق العام" في الأنظمة الشيوعية، حيث خلفت البروباغندا المرتبطة بالفكر الشيوعي بصورة عامة ما يشبه التطابق في معايير ومكونات الذوق العام لدى الشعوب الواقعة تحت هذا النوع من الحكم.
أما هنا فتشتهر مقولة مصرية تقول إن "الذوق مخرجش (لم يخرج) من مصر". كما تعرف منطقة الحسين الأثرية بالقاهرة ما يسمى "ضريح العارف بالله سيدي الذوق"، وهو مقام يعود تاريخه إلى عصر المماليك، وتنحصر القصص حول صاحب المقام في 3 روايات: الأولى تقول إنه كان تاجراً ومن فتوات المحروسة سعى دوماً لحل مشاكل أهالي الحي القديم، لكنه ضاق ذرعاً بالمشاجرات المتكررة فقرر أن يغادرها، ولشدة حزنه على فراقها لم يستطع استكمال المشوار فسقط ميتاً على بابها، وحزن عليه أهل المحروسة وقرروا أن يدفنوه مكان سقوطه ويصنعون له مقاماً.
وتقول الرواية الثانية إن صاحب الضريح كان شخصاً مباركاً لكنه قرر الرحيل بسبب ضيقه بأحوال البلاد، وقبل أن يخرج من "باب الفتوح" مات فأنشأ الأهالي الضريح مكان وفاته.
أما الرواية الثالثة فتقول إن صاحب القبر أصله مغربي جاء إلى مصر وعاش بين أهلها، لكنه حين مرض أراد أولاده نقله إلى بلاده ليموت ويدفن بها، وعندما رفض أجبروه على الرحيل فتوفى على "باب الفتوح" قبل أن يغادرها.
ونظراً إلى عدم وجود أي مصادر أو دراسات يعتد بها، أو نصوص شارحة في القوانين تعرف "الذوق العام"، على رغم وجود نصوص عقابية لمن يخالف "الذوق العام"، فقد لجأت "اندبندنت عربية" لـ"تشات جي بي تي" للمساعدة فخرج بالتالي "الذوق العام يشير إلى التفضيلات والمعايير الجمالية المشتركة لفئة أو عامة الناس، ويشمل ما يراه غالبية الناس جذاباً أو جيداً أو مرغوباً فيه في مجالات مختلفة، مثل الفن والترفيه والموضة وغيرها، ويتأثر هذا الذوق بالاتجاهات المجتمعية والأعراف الثقافية والتجارب الفردية".
الطريف أن البحث عن "الذوق العام في مصر" أدى إلى النتيجة التالية، "في مصر يتأثر الذوق العام تأثراً كبيراً بالدين والتقاليد والاتجاهات الثقافية المتطورة. وبينما لا تزال بعض الجوانب محافظة، لا سيما في ما يتعلق بالتعبير عن المشاعر في الأماكن العامة والزي المحتشم، فإن عقلية أكثر ليبرالية وانفتاحاً بدأت تظهر أيضاً".
وقرر "تشات جي بي تي" أن المكونات الثلاثة التالية تشكل الذوق العام في مصر: "التعبير عن مشاعر الحب بين المحبين في الأماكن العامة أمر مرفوض وغير مرحب به في مصر، والملابس المحتشمة لا سيما للنساء، واحترام الدين أمر مهم".
بحثاً عن تعريف
لم يحد "تشات جي بي تي" كثيراً عن مجموعة من الآراء أدلى بها قضاة سابقون ومتخصصون في القانون لصحيفة مصرية، إذ أجمعوا على أن "الذوق العام ليس له تعريف محدد في القانون، ولكنه جزء من نظام وآداب الدولة". وجاء في التقرير أن "الذوق العام، على رغم أنه جزء لا يتجزأ من النظام العام والآداب العامة للدولة، فإنه غير معرف في القانون، إذ لم يحدد له أي نص قانوني تعريفاً واضحاً. والمصطلح الأدق هو (النظام العام)، الذي حدد القانون عقوبات واضحة لمن يخرقه".
كما أُشير إلى أن "الذوق العام، سواء لدى المواطن أو المشرع في حاجة إلى توضيح، فهو في الأساس ما يقرره العرف الذي هو مصدر أساس للتشريع بعد الشريعة الإسلامية في الدستور المصري، وما يخالف العرف قطعاً يخالف القانون حتى وإن كان بصورة غير مباشرة، لذا يستوجب العقاب".
ربما يساعد ذلك في تفسير مطاردة فتيات ونساء يقدمن محتوى على منصات الـ"سوشيال ميديا" يراه بعض المصريين مفسداً أو مهدداً أو هادماً لـ"الذوق العام"، ومعرضاً "الضوابط المجتمعية" للخطر الداهم، والدافع الأكثر شيوعاً هو ملابس أو صوت أو حركات أو آراء ترد في هذا المحتوى النسائي.
اللافت أن أصواتاً عدة تطالب أو تجتهد لإصلاح "الذوق العام" بين وقت وآخر، لكن غالب المطالبات لا تسفر عن إصلاحات، ربما لأن تصحيح مسار الذوق العام لم يجد بعد من يعي كيفية إصلاحه. عام 2019 تقدمت نائبة البرلمان غادة عجمي بمشروع قانون لإصلاح الذوق العام، وجاء في تقديمها المشروع أنه "مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي يمكن تعريفها باللياقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية يبدأ تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس النواب".
وأشارت إلى أن القوانين المصرية تمنع المساس بالذوق العام أو التقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية، وأن هذه القوانين يجب أن تطبق على مرتادي الأماكن العامة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية.
وجاء ضمن نصوص القانون المقترح أنه "لا يجوز الوجود في مكان عام بملابس غير محتشمة، أو ارتداء زي أو ملابس عليها صور أو أشكال أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام".
ولحسن الحظ أن القانون لم ير النور، إذ الخط الفاصل بين حرية المصريين والمصريات في ارتداء الملابس وتخصيص وحدات شرطية لمراجعة معايير الملابس ورصد المكتوب أو المرسوم عليها كان يمكن أن ينهار.
محاولة أخرى أكثر واقعية ولكنها شديدة المحدودية بذلتها متخصصة الإتيكيت ماغي الحكيم قبل 15 عاماً، حين دشنت مبادرة أطلقت عليها "كلك ذوق"، وقالت الحكيم في حينها إنها لاحظت تدنياً في سلوكيات بعض المصريين في الشارع من تحرش وإلقاء قمامة والتفوُّه بألفاظ غير لائقة وعدم احترام الملكية العامة وعشوائية سلوك وغيرها.
المبادرة تبخرت في هواء الزمن والأحداث وتوسع قاعدة تدهور الذوق العام، ومعها تركز تحويل دفة الاتهام، واعتبارها والأغاني والمطربين المتهم الأول المسؤول عن تدني أو إفساد الذوق العام.
أزمة متعددة الأبعاد
الكاتب والسيناريست الراحل عاطف بشاي ظل من أكثر المهتمين والمهمومين بـ"الذوق العام"، والأكثر تعاملاً مع مشكلة تدني مكوناته من منظور شامل ومنطقي. كتب تحت عنوان "الذوق العام وأزمة الثقافة" (2020) التشريح التالي "الاعتياد على القبح يحيله إلى جمال، والفنون التي تتراجع هي بالضرورة الحتمية نتاج مجتمع متراجع. اعتياد مظاهر القبح يمثل أزمة ثقافة، كذلك فإنه أزمة مجتمع. وانحدار الذوق العام وتدنيه انعكاس لتدني الفنون والآداب، فهبوط مستوى الأفلام السينمائية يؤثر سلباً أيضاً في عقل ووجدان المتلقي، وبخاصة أن هذا التأثير يشمل انهيار القيم والأخلاق وشيوع العنف والاتجاه إلى الانتقام الفردي وتحدى القوانين والانتصار للبلطجة".
وتطرق إلى الأغنية باعتبارها "مظهراً من مظاهر أزمة الثقافة التي تكشف عن أزمات أخرى متعددة في الكلمة المكتوبة التي يسيطر عليها الابتذال والركاكة، واللحن الرديء الصاخب المزعج الذي يعكس ضوضاء عشوائية ويفتقر إلى الابتكار والخيال والأصوات الضعيفة وغير الموهوبة".
وكتب بشاي أنه "إذا كانت عبارة الذوق العام مطاطة، والجماهير العريضة تمثل كتلة بشرية مختلفة الثقافات والمعارف والميول والاتجاهات والطبقات، فالحقيقة أن القاعدة العريضة للجماهير ازدادت في الاتساع لتشمل أعداداً غفيرة تقبل إقبالاً كبيراً على السينما الرديئة، وهي على اتساق وانسجام وانبهار بما تقدمه، لذلك فإن المنع وفرض الوصاية هو أمر مضحك تماماً، ناهيك بأنه ضد الحرية الإنسانية التي تكفل حرية التعبير، فهو ليس علاجاً ناجعاً".
وعن الحل، كتب أن "للصفوة المثقفة والمتنورة في أي مجتمع دوراً جوهرياً في دعم الثقافة ونقدها ونشرها، ويجب على المؤسسة التعليمية أن تنطلق في أداء دورها من تربية الفكر والوجدان والانتماء، ولا تقتصر على حشو الرؤوس بالتفاصيل والجزئيات، مما نأمله في وسائل الاتصال الجماهيري لكي تضطلع بدورها كأداة لتوعية الشعب، والارتفاع بمستوى الذوق العام تداوي به قصور المدرسة وأبواق منابر التخلف الداعية إلى مزيد من التخلف".
في تلك الأثناء تنعقد اجتماعات اللجان المنوط بها إيجاد مخرج للذوق العام المتضرر والضوابط المجتمعية المتألمة عبر البحث في شؤون الدراما وسبل الارتقاء بها، لتدفع معها الذوق وكذلك الضوابط إلى أعلى، أما الذوق العام نفسه فلا يزال في رحلة بحث عن الذات.










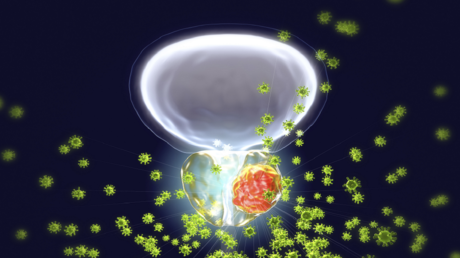






 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·