ARTICLE AD BOX
ما الذي يجعل صوتاً يستمر في الحياة، حتى بعد أن تتغير خرائط السياسة والثقافة؟ وهل يمكن لفنانة مثل أم كلثوم أن تتحول من مجرد صوت إلى ما يشبه الأثر الوجداني، الذي لا يُمحى رغم كل محاولات الإقصاء؟ في هذا الإطار، يأتي كتاب "أم كلثوم والأتراك" للباحث والناقد الموسيقي التركي مراد أوزيلدريم، الصادر مؤخّراً عن دار مرفأ للثقافة والنشر، بترجمة مشتركة إلى العربية قام بها كلٌّ من أحمد زكريا وملاك دينيز أوزدمير.
لا يقدّم الكتاب دراسة عن شعب أحبَّ صوت أم كلثوم، بل يفتح سؤالاً أعمق عن الذاكرة والحنين والهوية، وعن الكيفية التي يُمكن بها للفن أن يتجاوز كونه متعة جمالية ليصير شكلاً من أشكال الارتباط العاطفي العميق بالماضي، أو حتى بالمقموع. هو قراءة في المشاعر المتوارية تحت الصوت، وفي طبقات السمع التي تُخفي أكثر مما تُظهر. في بلد شهد قطيعة حادة مع ماضيه الشرقي، بدا أن صوت أم كلثوم لم يكن مجرد موروث فني، بل استمرار لما حاولت الدولة قطعه من الداخل.
ينقسم الكتاب إلى فصول تُمهّد للخلفية الثقافية والتاريخية للعلاقات العربية التركية، ثم ينتقل إلى توثيق شكل حضور أم كلثوم في تركيا عبر الإذاعة، والسينما، والصحافة، والأسطوانات. لاحقاً، يتوسّع ليعرض شهادات من أتراك استقر صوتها في ذاكراتهم، لا بوصفها فنانة عربية فقط، بل امتداداً لشيء شرقي داخلهم لم تعد تسمح به اللغة السياسية الرسمية. يعكس هذا التدرج في الفصول بنية تصاعدية في الحجة: من التأريخ إلى الوجدان، ومن العلن إلى الداخل.
لم يكن صوت أم كلثوم في تركيا مجرد تجربة سمعية تُلتقط من الراديو، بل شكل من أشكال الوجود الثقافي الذي استمر في الحياة، رغم محاولات طمسه من الفضاء العام. كما يرى الفرنسيّ موريس ميرلو-بونتي، لا يُختصر الصوت في ما نسمعه، بل في ما يوقظه فينا من إحساس بأننا ما زلنا هناك - حيث ينتمي جزء منا، رغم كل محاولات الاقتلاع.
لم يكن صوتها مجرد حضور فني، بل مقاومة وجدانية صامتة
وهذا ما فعله صوت أم كلثوم: لم يعد فقط غناء، بل نداء باطني يستحضر الذات المُغيَّبة في سياقٍ أُعيد فيه تعريف الانتماء من الأعلى. هكذا، يقدّم مراد أوزيلدريم في كتابه صوت الفنانة المصرية لا بوصفه أداء موسيقياً، بل "نداء" - بلغة هايدغر - يُعيد تنشيط ما تم تغييبه عمداً. وكما كتب هايدغر: "النداء لا يُعلن شيئاً، لا يُعطي معلومات، بل يدعو الدازاين إلى أن يكون هو نفسه على نحو أصيل". في هذا النداء، لا يُسمع شيء محدد، بل يُستحضر ما فُقد. أم كلثوم ليست فنانة تُسجَّل، بل ذاكرة تُستَعاد. ليست مؤدية تُعجِب، بل أثر وجداني يُصرّ على البقاء حين تُعاد كتابة الذائقة من فوق.
وقد أشار أوزيلدريم إلى أن صوت أم كلثوم ظلّ في ذاكرة كثير من الأتراك الأكبر سناً، حتى لدى من لم يفهموا كلماتها، قائلاً: "ولهذا السبب استمع كثير من الأتراك لأم كلثوم بإعجاب لسنوات عديدة... لا يزال من الممكن العثور على شيء عنها في ذاكرة عدد من الأتراك الأكبر سنّاً اليوم". في إحدى الشهادات، يقول أحدهم: "كنا نشاهد القنوات العربية ونستمع إلى أم كلثوم... لم نكن نعرف من هي، لكن كان لديها صوت جميل".
الاستماع هنا لم يكن فعل ترف، بل حاجة شعورية ومقاومة صامتة، تمارس حضورها من خارج السياسة، في هوامش الحياة اليومية. الصوت الذي حُجب من المسارح والمناهج، وجد موضعه في الراديو، وفي الذاكرة، وفي الذوق الذي لا يُهندس بمرسوم. لقد أصبح الغياب شرطاً لحضور أكثر كثافة؛ حضور لا تحكمه سلطة العرض، بل تستدعيه رغبة التذكّر.
في هذا السياق، لم تكن القطيعة مع الشرق في تركيا مجرد تعديل في السياسات، بل مشروع جذري لإعادة تعريف الذات القومية على نحو يفصلها عن تراثها العثماني والإسلامي والعربي. أُعيد تقديم الشرق بصفة "آخر داخلي" تجب تصفيته، ولهذا لم يكن صوت أم كلثوم مجرد صدًى ثقافي، بل كان عنصراً مربكاً في النظام الرمزي الجديد - لأنه يُعيد التذكير بما طُمِس عمداً، ويوقظ ما أُريد تجاوزه. وفي وصف دقيق، كتب المؤلف: "ما ينقله الأتراك عن أم كلثوم في ذاكرتهم مهم؛ لأنه يعيدنا إلى تلك الأيام". هكذا، لم يكن صوتها مجرد حضور فني، بل مقاومة وجدانية صامتة، استقرت في الأذن التي تصغي، في الذاكرة التي تحفظ، وفي التوق الذي لا ينقطع. ليست ماضياً يُستعاد، بل ما لم يمت أصلاً.
بقي صوت أم كلثوم حياً في وجدان الأتراك، لا استذكاراً، بل فعلاً يومياً يُمارس به الأفراد سيادتهم على ذائقتهم، خارج أعين الدولة. لم يكن الاستماع إليها فعل احتجاج معلن، بل استجابة وجدانية لتعويض غياب لم يعوّضه البديل. ومع الزمن، صار صوتها أقرب إلى ما يسمّيه جاك دريدا بـ"الأثر": ليس حضوراً مرئياً أو مباشراً، بل ما يظل يعمل بعد غياب الأصل؛ شيء لم يعد قائمًا بشكله الكامل، لكنه حاضر بأثره، بما يتركه في النفس من نداء داخلي يصعب محوه. وفي مجتمع أُعيد فيه تشكيل الانتماء من الأعلى، لم يكن الحنين إلى هذا الصوت نوستالجيا، بل مقاومة ناعمة تُبقي ما لم يُسمح له بالبقاء.
وقد أشار أوزيلدريم إلى أن صوت أم كلثوم ظل راسخاً في الذاكرة التركية حتى لدى من لم يفهموا كلماتها، لأن "في صوتها طاقة طربية تستثير الشعور وتبعث الانتماء"، ولأن "شيئاً منها لا يزال في ذاكرة كثير من الأتراك الأكبر سنّاً". تتجسد هذه العلاقة الحميمة في الشهادات التي نقلها المؤلف، مثل رواية أحد الطلاب في إسطنبول عن زميله الذي كان يبحث ليلاً عن إذاعة القاهرة ليستمع إلى أم كلثوم، طالباً من رفاقه الصمت احتراماً للصوت. لم تكن هذه مجرد عادة، بل فعل شعوري سيادي، يُمارس في الخفاء ليبقي ما حُظر في العلن. في عالم تُفرض فيه نماذج موحّدة للذوق والانتماء، يصبح الاستماع اختيارًا حرًّا، ووسيلة لحيازة ما سُلب. وهكذا، لم يكن صوت أم كلثوم تكراراً لماضٍ منتهٍ، بل هو أثر يُستعاد، وهوية باطنة تبحث عن صيغة للبقاء وسط عالم يعيد تعريف كل ما يُسمع وما لا يُسمع.
ظل صوتها راسخاً في الذاكرة التركية حتى لدى من لم يفهموا كلماتها
في زمن تُلغى فيه الموسيقى الشرقية من المناهج وتُقصى من الفضاء الإعلامي، لا يكون الاستماع إلى صوت أم كلثوم مجرد تفضيل فني، بل هو إعلان هادئ أن الذاكرة لا تُدار من الخارج. أن تُصغي لصوتها، في مثل هذا السياق، هو أن تقول من دون تصريح: "أنا أختار أن أتذكّر". لكن هذا التذكّر لا ينبع من حنين سطحي أو نوستالجيا عاطفية، بل من حاجة داخلية إلى صيانة ما لم يعد مسموحاً له بالظهور علناً.
فحين يُمنع الحضور، ويُعاد تنظيم الشعور وفق هوية رسمية، يصبح الحنين فعلاً مضاداً للهندسة الثقافية، لا بوصفه صخباً، بل بوصفه استمرارية صامتة. بهذا المعنى، لم تكن أم كلثوم مجرد فنانة تحضر في ذاكرة جمهور، بل شاهد حي على أن ما يُراد طمسه يمكن أن يختار البقاء بصيغة أخرى: الصوت. فالصوت لا يحتاج إلى تصريح، ولا يسكن في الكتب، بل في الأذن والقلب والتوق. وهنا، لا يصبح السؤال عن الماضي فقط، بل عن الحاضر: ليس ماذا تبقّى من ذلك الصوت، بل ماذا يكشف عنّا حين نستمر في الإصغاء إليه؟
إذا كان صوت أم كلثوم قد أدى دور الحارس غير المرئي لذاكرة مضادة، فإن السؤال يبقى اليوم: هل لا تزال أصوات مماثلة قادرة على مقاومة أنظمة النسيان الجديدة؟ في هذا المعنى، لا تنتهي قراءة كتاب "أم كلثوم والأتراك" بانتهاء صفحاته، بل تبدأ منها أسئلة الذاكرة، والهوية، والمقاومة التي لا تحتاج إلى إعلان، بقدر ما تحتاج إلى أذن تصغي ولا تنسى.
* باحثة ومترجمة فلسطينية


.png) 23 hours ago
2
23 hours ago
2
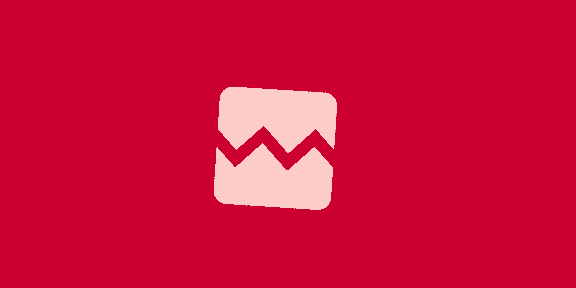







 Arabic (IQ) ·
Arabic (IQ) ·  English (US) ·
English (US) ·